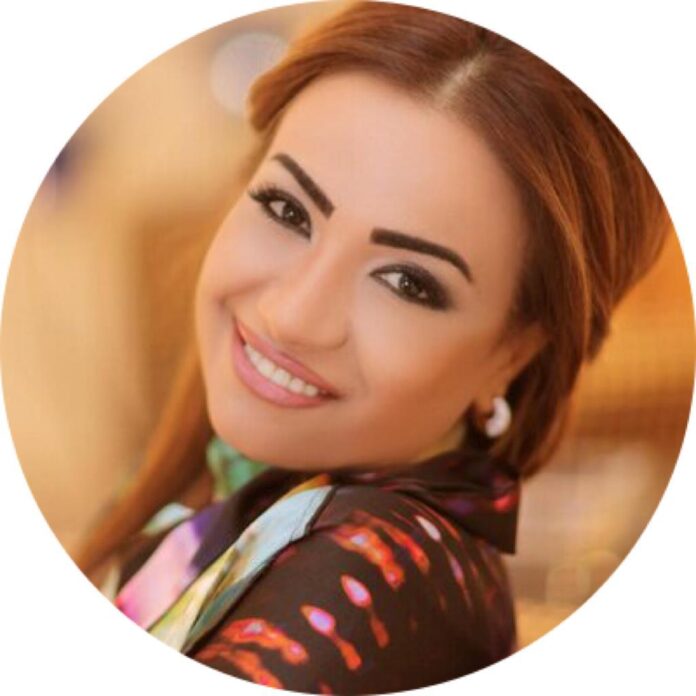نعرف جيداً أن القارئ الذي يعمل على انتشار أي عمل أدبي “قارئ ناقد”، وهو يضفي عليه شرعية ما تجعله يكتسب سمعة معينة فإمّا يزكيه أو يشوهه، وذلك وفق نظرته الجمالية لمعايير أدبية قد تتوفّر في العمل وقد لا تتوفّر.
وهذا لا يعني أنه عارف بالقواعد الأدبية أو النقدية، فكل ما في الأمر أنّ هذا القارئ لا يكتفي بتلقي النص بل يتجاوزه إلى التفاعل معه حسب الظروف التي تحيط به، وتتحكّم في ذائقته ومدى إدراكه لأبعاد ما يحدث حوله. يلعب الظرف السياسي الاجتماعي على وجه الخصوص دورا مهما في مراوغة وعيه، وهذا ما يجعل مسار استقبال أي عمل أدبي يتعرقل أحيانا، دون الانتباه لقيمته الأدبية.
ففي الغالب يتفاعل الجمهور سريعاً مع ما يخرج عن أفق توقعه، يتلقفه بسرعة ليدلق بدلوه، تجذبه الفضيحة مثلا أكثر من غيرها، منع الرقابة، تصريحات الكاتب الصادمة، أمور كهذه تجعله يندمج مع الضجيج المؤقت، ناسيا تماما أنه يوجد أعمال مهمة في الضفة الهادئة غير البعيدة عن نظره.
صحيح أن الأدب يغير تصوراتنا الجمالية والحسية للعالم، بحكم أن الكاتب رجل مختلف ورُؤاهُ تُنتقَل إلى جمهور قرّائه، لكن ميكانيزمات القراءة لها أسرارها، فهي لا تتحكم في تصوراتنا فقط بل تعيد إنشاء العالم.
إذ يقال أن الأدب القائم على اللغة يستمد هذه القوة منها، لهذا دعونا نتذكّر قاعدة الآباء لنا حين كنا أطفالا: “هناك ما يقال، وهناك ما لا يقال”، “لسانك حصانك”، “إذا كان الكلام من فضة فالصمت من ذهب”…إلخ
خطورة الكلمة تعيدنا إلى عمرنا المبكّر، حين نتعلّم الكلام، فنخضع لعملية فرز لما يباح التلفُّظ به وما لا يُباح. فنتدرّب على تصنيف الكلمات، لأنّها سبيلنا الوحيد لشق طريقنا في الحياة، فبهذه الكلمات نكسب أصدقاء كما نكسب أعداء، وبها نحقق مكاسب كما قد نحقق خسائر، تبقى الخيارات في أيدينا، لخوض لعبة الكلمات تلك، أمّا القدرة على الخروج منها بسلام فهنا تكمن الشطارة.
الأدباء إذن يعرفون أسرار هذه اللعبة، (وينافسهم في ذلك رجال السياسة) وهم أكثر من يدخل فيها لأهداف مختلفة، قد تكون انصياعا فطريا لغواية اللغة، وقد تكون غير ذلك.
يوقظ الكاتب حواس قارئه ومشاعره وذكائه وضميره ليقوده إلى التشبع بفكرة ما بمقدار الكلمات المؤثرة والمباشرة التي يختارها لنسيجه اللغوي. يرتدي عباءة القائد الذي يجعل القارئ يتطوّر في مفهومه الأخلاقي ويغير من سلوكه، كما قد يرتدي عباءة المؤثر الذي يحث قارئه على العمل، أو المرشد المستنير، أو المخلِّص. ثمّة حقل دلالي كامل لكل كاتب يكشف منظومته اللغوية التي تشيِّد سمعته، بعدها يصعب خلع تلك العباءة لأنها تصبح قدرا يلاحق صاحبه حتى آخر يوم في حياته.
بطبيعة الحال للقارئ كامل الحرية في رفض المقترح الجمالي المُقِدّم له وإغلاق الكتاب، فالقراءة فعل حرٌّ بكل ما تحمل الكلمة من معنى، بين القبول والرّفض، بين الدخول والخروج من العمل يسقط أي فعل إرغامي قد يخطر على البال. ينشأ الصراع السياسي من هذه النّقطة، بين الكتّاب والشعراء والمبدعين، وصنّاع القرار السياسي، لهذا يلجأ هؤلاء إلى تقنيات الحجب، فما يذهب إليه القارئ حرًّا بالتأكيد أخطر بكثير مما يذهب إليه مكبّلا.
القراءة كما قال بول ريكور مكان للخلق، والعمل، إنها لا تختلف عن الكتابة، لهذا نجد تقاربا كبيرا بين المؤلف والقارئ.
نشعر بشكل ما أن المؤلف والقارئ يتقاسمان ساحة واحدة، ويتلاعبان بكرة يتقاذفانها معا في انسجام كبير. ربما تذهب بنا المخيلة بعيدا بتصوُّر مدى تناغم أدائهما معا، لكن ما هو أكيد هو أن أرضهما واحدة.
يتعلّم الكاتب المراوغة باللغة، ويتعلم القارئ فك رموز الغموض الذي يحتويه النص باعتماد مراوغات التأويل. يقرأ مرة وقد يعيد القراءة عدة مرات حتى يجد المعنى ويعيد بناءه بطرقه الإدراكية، وهو متحرر بشكل كامل من سلطة النص.
نخلص إلى نتيجة مهمة وهي أن القارئ كلما تفاعل مع النص وناقشه ازداد تحررا. ولكن سؤالا خطيرا يُطرح هنا: ماذا لو وقع القارئ تحت سحر الكاتب إعلاميا؟ إذ يبدو أن حالة الانبهار هذه قد تعيق التفكير النّقدي وتأخذه لأماكن مغلقة تشبه السجن. فالأدب معرفة وليس مجرّد ترفيه أو مادة مخدّرة، وهذا أمر أساسي للمضي في فعل القراءة دون مؤثرات. بحيث إن لم يتم في فضاء حر، لم يكتمل أبدا.
بالنسبة لي العمل يخلق المؤلّف والقارئ في الوقت نفسه، أما سلطته فيستمدها من انتصاره في معركة النّقد، وإعادة بنائه خلال رحلات القراءة المتنوعة، وكلما تعددت القراءات اتسع المعنى، وبسط سلطته أكثر.
الأكثر جدلا إذن هو الأكثر قوة، فثمة نصوص تعجبنا، ولكنّها من كثرة اعجابنا وانبهارنا بها نقتلها، كونها تجد نفسها خارج حلبة النّقد سريعا، يقتلها الصمت. أمّا بعيدا عن الإعجاب المبالغ فيه، فإننا حتما نتذكر غوستاف فلوبير الذي قال: “القراءة تحركني أكثر من أي مصيبة حقيقية” وهي فعلا كذلك، خاصة حين تشعل حرائق في الذات، لا شيء يخمدها غير نفاذ وقودها.
في روايته الشهيرة البؤساء، يشبّه فيكتور هيغو القراءة بإشعال النار، وكل مقطع لفظي بالشرارة، لم يكن مخطئا، فالقراءة مثل النّار بعد اكتشافها لا شيء بقي على حاله. وحين تأخذنا الحيرة لأن نصاً من القرن التاسع عشر أو السابع عشر لا يزال متوهجاً ويجذب قراء من كل الأعمار نتأكد أن الكاتب حين يكتب يفلت تماما من قبضة الزمن، إنه يطلق سراح الفكرة ويتركها تشق طريقها وفق مشيئة القراء.
قد يقول البعض أن المرء لا يكتب لقرّاء القرن التاسع عشر كما في القرن العشرين، وهذا صحيح، لكن الفكرة متى ما ولدت تطوّرت وانبثقت منها أفكار جديدة، وهذا مرتبط بمدى كفاءة القراء، وأعتقد أن هذا الأمر واضح رغم التعقيد الدلالي لمفهوم القراءة.
فالقراء عموما لديهم قواسم مشتركة أحيانا تتجاوز الاختلافات الثقافية، وهذا يعني أن هناك دائما بعدين في القراءة: أحدهما مشترك يحدّده النص، والآخر متغير لأنه يعتمد على البصمة الثقافية للقارئ، أو لنقل على ما يقدّمه كل واحد من نفسه (قرأت هذه الفكرة في مكان ما ولا أتذكر مرجعها للأسف)…
نقف بعد العرض المختصر لدور القارئ في منح تأشيرة نجاح للعمل الأدبي عند عتبة غير مفهومة جيدا، وهي “لماذا بعض الأعمال تظل محفورة في ذهن القارئ وبعضها لا؟” أو لنسأل بصريح العبارة أي نوع من القُرّاء هو الذي يصنع نجاح العمل؟ يقول العارفون بخبايا النجاحات على أشكالها العديدة أن المصائر الاستثنائية لبعض الأعمال متعلّقة بأسباب أخرى غير الترويج الذي يقوم به القارئ لها. فالنجاح ربما يكون مرتبطا بشخصيات الرواية الناجحة، وهنا يبرز دور المؤلّف الذي لا يمكن الغاؤه، حين يدرك ما يود القارئ أن يكون عليه فيطبع في ذهنه صورة تعوّضه عن الحياة التي لديه.
ألم أقل لكم أن ملعب الأدب يلتقي فيه الكاتب بقرائه ويلعبان اللعبة نفسها دون كلل أو ملل؟ لكن علينا أن نتذكّر أن الفاشل يبحث عن شخصية فاشلة في الأدب ليعرف مصيره، والمظلوم يبحث عن المظلومين مثله، وفاقد الحب يبحث عن شبيهه، ولكن تكريس الفشل والظلم وخيبات الحب يكسر القارئ، إنّه بالتأكيد يبحث عن منفذ نور لمتاعبه الشخصية، لهذا يستحيل أن يروّج لعمل يزيد من تشويه ذاته وسحقها.