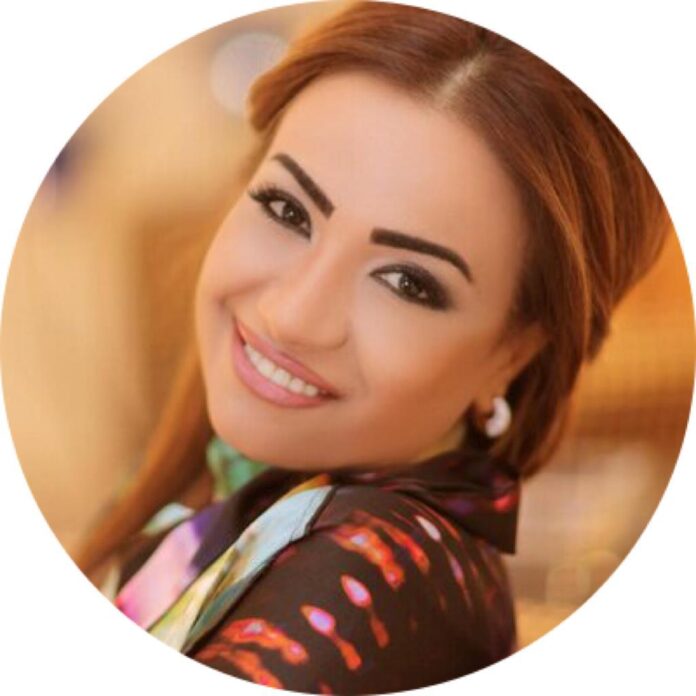لا أحد يختار أبويه، إنّه القدر أو الصدفة المحضة، أو أي شيء آخر تعجزون عن وصفه وإيجاد تفسير له. تأتي إلى الحياة فتفاجئك الأيام على مدى حياتك كاملة بأمور لا تفهم لماذا تحدث.
هذا ما حدث لفتاة أمريكية إسمها جانيت، ولدت لأبوين بوهميين، يعيشان حياة غريبة متنقلين بين أماكن عدة دون استقرار (حوالي عشرين مكانا مختلفا). ولم تكن وحيدتهما، بل كان لها أخ براين وأختين لوري ومورين.
تشرّد الأطفال الأربعة مع والديهما، أب حالم ومدمن على الكحول وأم ترسم لوحات غير ذات قيمة، ومع هذا حين جمعت جانيت أطراف علاقتها بوالدها تحديدا وأعادت بناءها في شكل رواية سيرية، اكتشفت محاسن الأب الذي شكّل شخصيتها ككاتبة. إنها جانيت وولز، صاحبة كتاب “القلعة الزجاجية” الصادر في 2005 والذي باع أكثر من أربعة ملايين نسخة وترجم لأكثر من ثلاثين لغة، نال أكثر من جائزة، ونقله إلى السينما داستن دانيال كريتون العام 2017.
نشأت الطفلة جانيت على حياة مليئة بالشعر والأحلام والجوع والعوز والفقر، تشوّه جزء من جسدها بسبب حريق تعرّضت له وهي في الثالثة من عمرها حين اضطرّت لتحضير وجبتها بنفسها، وذات مرة سقطت من السيارة ولم ينتبه والديها لذلك، وأمور أخرى تذكرها كحوادث غريبة تعرّضت لها، ولكن هذه البيئة غير المستقرة على الهامش السيء للمعقول لم تذهب بها إلى مصائر محزنة، لقد نما وعيها ووعي أخوتها من تلك التناقضات الجارحة التي شكّلت طفولتهم، قرروا الهروب تباعا من جحيم أبويهما، وخاضوا جميعا مغامرة التحليق الحر نحو أحلام قابلة للتحقيق.
في نيويورك، المدينة التي فتحت ذراعيها لجانيت، يمكن لأي شخص في عمر الشباب أن يكسب عيشه، ويتعلّم ويتسلّق درجات السلّم بخطوات ثابتة ليحقق ما يريد. يكفي أن يشدّد على نواياه بعزيمته مرددا “يس آي كان” نعم أستطيع. وهذا كان سلاح الصبية ابنة السابعة عشر عاما، التي رفضت نمط عيش والديها وخيارهما الغريب لبناء عائلة في تلك الفوضى العارمة.
إن شيئا غير مرتبط بالحظ بتاتاً هو الذي جعل الأخوة الأربعة يتماسكون ويستمرون في شقّ طريقهم، لقد أرادوا دائما أن يكونوا في الضفة الأخرى المشرقة من الحياة، عكس ما وجدوا عليه أنفسهم. إنّ الأقدار وفق تعريف جانيت ووولز هي ما نولد ونجد أنفسنا عالقين فيه، شيء أشبه بما قاله الكاتب المغربي محمد شكري في سرد سيرته، لكن متى ما تشكّل المرء تصبح القيادة في يده.
لم تسأل وولز لماذا قرّر مقسّم الأرزاق أن يقذف بهم في كنف عائلة لا مسؤولة كتلك التي حظيت بها، لقد اعتبرت ما حدث طريقة لرفع التّحدي أمامها وما مدى قدرتها على الخروج من تلك القوقعة المظلمة، وقد فهمت كل الإشارات التي كانت بمثابة شيفرة لبلوغ شاطئ الأمان الذي رسمته لخوض تجربة مختلفة.
في بيئتها الصغيرة عرفت معنى أن تعيش على الهامش، كما أدركت في مواقف كثيرة أن الهامش خيار لمن يريده، ولأنها خبرت الفقر، والجوع والظلم والخوف والوقوف في مهب التغيرات العنيفة باستمرار اتخذت خيارا آخر تتوفّر فيه عناصر الإكتفاء والعدالة والأمن والاستقرار. اجتهدت وكان لها ما تريد.
النهاية السعيدة في قصّتها لها حتما تأثيرجيد على القرّاء، ما جعل كتابها يتربع على عرش المبيعات على مدى ثمان سنوات، لكن القارئ الغربي عموما يحب أن يتعرّف على أشخاص تمكنوا من التغلًّب على محنهم بالمثابرة والاجتهاد. وهذا النّموذج من القصص وإن توفّر لدينا فإنّه يصطدم دوما بمعطيات الواقع السّوداوي التي تجعل القارئ العربي لا يصدّق النهايات السعيدة لقصصنا، حتى وإن اتكّأت على وقائع حقيقية.
ولا أدري، ونحن في زمن تلاقح الثقافات عبر الفضاء الافتراضي، وبروز مؤثرين من كل لون، يشجعون الأجيال الجديدة على مقاومة العقبات وتخطيها بسرد قصصهم، هل سنبلغ تلك المرحلة من تشجيع أدب مغاير لما ينتشر عندنا.
أطرح هذا المعطى بدون تأفف مما هو موجود، كون أدبنا يزخر بتجارب عظيمة لا يمكن التقليل من قيمتها، لكني تساءلت كثيرا وأنا أتقفى مراحل حياة جانيت لو أنها ولدت في بيئتنا العربية بنفس المعطيات هل ستنجو من مستقبل قاتم؟ تلعب العائلة دورا مهما لحماية ورعاية أبنائها، ومع هذا يظل أفق النجاح الباهر لدينا مرتبطا بالحظ، والعلاقات، أتذكرمرة أخرى محمد شكري الذي رغم منجزه العظيم وتحدياته الكبرى لتحقيق حياة مستقرّة وكريمة إلاّ أنّه لم ينج من الدائرة العقيمة التي أحاطت به، إلى يومنا هذا تنهال الشتائم والعبارات البذيئة بكل أنواعها لاعنة روحه، مع أنّه كما قال: ” أكلت من القمامة، ونمت في الشوارع، فماذا تريدون؟ أن أكتب عن الفراشات!”
ومحمد شكري ليس نموذجا مًحبِطا للغاية فما حققه يبعث على الأمل فعلا، لأنّه عاش في بيئة قاسية بامتياز، أقسى بكثير من حياته بعد أن تعلّم القراءة والكتابة، وصنع إسما كبيرا في سماء الأدب، ولا عتب عليه في الحقيقة، لكن العتب على الناشرين الذين اقتاتوا من لحمه وتعاملوا معه بنكران عجيب، ومثله مثل عشرات الكُتَّاب العرب الذين لجأوا لدول غربية منها أمريكا نفسها، وصعب عليهم الإندماج، والتخلّص من حمولتهم العربية الثقيلة من الهزائم، والانكسارات.
يخرج قارئ وولز بكثير من الامتنان بعد قراءة كتابها، ويصفه بالمًلهم، والباعث للأمل في نفوس المكسورين. من خلال قراءتي لمراجعات عديدة قام بها قراؤها على موقع “غودريدز” اكتشفت أنهم أحبوا أيضا طريقة وصفها لمسببات الألم في حياتها دون أن تهمل استخراج جماليات عالية من رحمها، أمّا وعي الطفلة الذي امتلكته باكرا، فذلك ما يمكن اعتباره “هدية ربانية” حقيقية عرفت استخدامها بالاستثمار في كل ما عاشته من أوقات مظلمة وأخرى سعيدة.
في حوار يعود للعام 2017 أجرته معها مجلة ” people ” أنها كتبت تلك المذكرات بعد أن تأملت تلك الفوضى وتساءلت ماذا يمكنني أن أفعل بها؟ إنها مزيج من الذكريات الحزينة والسعيدة معا ولأنها بكمِّ هائل من الغرابة كان علي أن أسردها.
ذكرت الكاتبة أيضا كم كان ممتعا أن تحظى بأمِّ لا تشبه أمهات أترابها المثاليات اللواتي يصعب إرضاؤهن “أمي لم تنتقدني أبدا، لم تخبرني بما تريده مني، لم ترفض أبدا أي شيء فعلته، وبالمقابل هي ليست فخورة بي، أقول ذلك بدون مرارة أو غضب، ليس لديها أي إحساس بالملكية تجاهي” ولكنّها تضيف: “لو عاش أبي لكان فخورا بي، لكني كنت سأكون فخورة بنفسي أكثر لو أني أقنعته بالإقلاع عن الشرب”.
تغيرت حياة وولز بعد هذا الكتاب، ارتاحت من العمل الصحفي المنهك، وتفرّغت للكتابة. وابتاعت بيتا كبيرا ومزرعة. بالتأكيد ظلّت تتذكر القلعة الزجاجية التي وعدها والدها بها وظلّ يصممها دون أية نية في تشييدها، لكنّها أدركت في الأخير أن “القلعة الزجاجية” لم تكن تتعلّق بهيكل مادي بقدر ما كانت تدور حول أمل وحلم مستقبل. شيّدت قلعتها الزجاجية بنفسها، ووقفت فيها بكل أسرار عائلتها التي ظنت لسنوات أنها مخجلة.
فصول من الكتاب متوفرة على الأنترنت باللغة الإنجليزية، أمّا الفيلم فمتوفّر على نتفليكس لمن يريد إجراء مقاربة بين المادتين الأدبية والسينمائية.
أما أنا فمريضة بالمقاربات والمقارنات مع أدبنا العربي وبيئتنا العربية وظروف الأدباء العرب التي لا تتحسن حتى حين يهاجرون إلى آخر الدنيا.