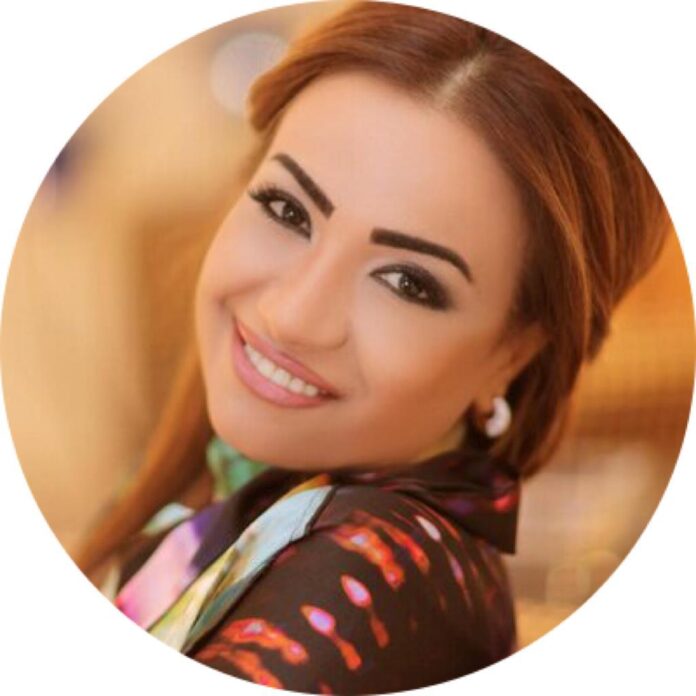هل يمكن للكاتب أن يعيش في صخب الحياة الجديدة؟ هل يمكنه فعلا أن يتواجد على منصات التواصل الاجتماعي، والحياة الاجتماعية في الواقع؟ ويكشف الكثير من أسراره لمتابعيه، ليكسب مزيداً منهم، ويقضي يومياً عدة ساعات في ذلك الرّكض السريع لإثبات حضوره في تلك الشبكة المعقّدة من العلاقات الإفتراضية التي لا صمّام أمان لها.
هذه قائمة جديدة من المشكلات التي على الكاتب أن يتصارع معها، ويخوض قتالاً دائماً ليثبت وجوده شرط الإبقاء على حريته. متاهة عبثية قد تكون نهايتها وخيمة بالنسبة لمن يحلم ببيئة متناغمة تحافظ على ينابيع موهبته. يقول هنري ميللر: “يجب على الرّجل الموهوب أن يعيش على الهامش، أو أن يخلق على هامش حياته”. كلام يبين مدى صعوبة الخيارين.
في عالم الأدباء نسمع كثيرا ذلك الوصف الذي يضعهم خارج المفهوم الطبيعي للبشر، إنهم أشخاص غريبو الأطوار، بعضهم تبرز عنده انحرافات خطيرة، مثل أوسكار وايلد، أو بودلير، أو آرثر رامبو وبول فرلان… البعض الآخر يكون لديه مزاج متقلب مزعج، أو بعض التعجرف أو ما شابه من سلوكات غريبة. قلّة هم “المعتدلون” لكن صفة الاعتدال عادة كأنها تصب في خانة اللاّ تميُّز.
بعيدا عن العرض الأكاديمي، قد تكون كل تلك الآراء صحيحة، فوفقا لدراسة حديثة فإن الأدباء على وجه الخصوص والأشخاص الذين يكرسون حياتهم للفن هم أكثر عرضة للإصابة ببعض الاضطرابات العقلية، والعديد من تلك الاضطرابات ناتجة عن التوتر والقلق خوفاً من عدم إنهاء العمل في الوقت المحدّد وفقدان الإلهام للقيام بذلك. كثيرون لهذا السبب عانوا من مشاكل الإدمان بأنواعها، وبلغ بهم التعب والمرض أن أصيبوا بأمراض عقلية فعلا.
أشهر هؤلاء الكتاب على الإطلاق همنغواي الذي ورث عن بعض أفراد عائلته جينات الإكتئاب والإنتحار. إذ اعترف أكثر من مرة أنه كان يعاني من اضطراب ثنائي القطب، والاكتئاب والذّهان، كما اشتهر بنرجسيته الزائدة، ورغم محاولة آخر زوجاته حمايته من نفسه، إلاّ أنه أطلق على نفسه النّار ببندقيته الخاصة يوم 2 يوليو/ تموز 1961 ولقي حتفه مباشرة.
أمّا فرجينيا وولف فقد كانت معاناتها من صنف آخر، وبدأت باكرا في طفولتها حين تعرضت لاعتداء جنسي، وكانت مع مع تقدمها في العمر وإدراكها لفداحة ما تعرّضت له تكبر صدمتها، في العشرين من عمرها أصيبت بأول انهيار عصبي، ولم تشف أبدا من ذلك الجرح الذي أثار لديها أسئلة وجودية ضخمة، إضافة إلى مشاكل أخرى من تمييز جنسي إلى فقد بيتها في لندن خلال الحرب العالمية الثانية، في ربيع 1941 ملأت جيوبها بالحجارة ودخلت النهر بالقرب من بيتها وماتت غرقا.
الكاتب الألماني العظيم هرمان هسه ألحقه والده بعيادة نفسية باكراً، بعد أن تكرّر هروبه من المدرسة وحاول الانتحار مرة وهو بعد في الخامسة عشرة، تعاطى الكحول ودخّن بعض الممنوعات، عاش معاناة قدرية غريبة حتى في زواجه اتضح أن زوجته مصابة بالفصام كما أنجبا إبنا مريضا، أمّا كيف تجاوز كل تلك الأزمات، فلا بد أن عبقريته هي التي انقذته في النهاية لأنه كان يعي حجم مشكلته ومشكلة عائلته.
عاش خمسا وثمانين سنة، نال جائزة نوبل، ابتعد عن الكتابة في أواخر عمره لكن أجيالا من الشباب في العالم كله أحبت أدبه وتأثرت به.
إن كان هذا خيط الجنون الذي يجعل بعض الأدباء يعيشون حياة في منتهى البؤس لتفرز أدمغتهم كمًّا هائلا من العبقرية، فهو حتما الخيط الذي يتحوّل لعائق كبير لذويهم. فهم في الغالب يحتاجون لفضاءاتهم الخاصة، لعزلة ما، لمسافات تفصلهم عن الآخرين، دون أن تقاطعهم تماما، يسلكون مسارات في الحياة لا يسلكها الآخرون.
يقال إن طرق الأدباء والفنانين تنحرف قليلاً عن الدروب المعهودة، وهم في الغالب ينقادون لخيارات مختلفة تقودهم أولاً للمعابر النّفسية الخطيرة، إلى الوحدة في كثير من الأحيان، إلى الهزّات العاطفية العنيفة، إلى المرايا التي تكشف تشوهات الذات، ولا تفسير لتلك المغامرة التي لا تتوقف لعقل لا يعرف الاسترخاء.
وسواء تحدثنا عن همنغواي أو وولف أو هسه، أو آخرين، فالقلق واحد، والرّغبة في إصلاح اعوجاج العالم واحدة، بقي أن نعرف ما درجة تحمّل الأدباء لهذا الصخب الجديد الذي ملأ العالم من حولهم؟
مشكلة الكاتب اليوم تزداد تفاقماً وهو يواجه جحافل من المؤثرين الذين يستغلونه بطريقة لا أخلاقية، ويستولون على ممتلكاته الفكرية لصنع شهرتهم. فيما يشعر بالعجز لاقتحام فضاءاتهم وإيجاد مكان بينهم.
حتى فسحة الكتابة التي يطلبها يملأها هؤلاء المهرّجون الجدد بضجيجهم. فما الخيارات التي بقيت لديه؟
المؤكّد أن الطّبع يغلب التطبُّع، وأن طبيعة الأشخاص التي تأقلمت مع معطيات العصر الجديدة، تشبه إلى حدّ ما البرمجة الجاهزة، هذه الفئة من الناس لم تجد فرصة للظهور فقط فيما سبق، أمَا وقد توفّرت اليوم فمن يوقفها؟ إنّه زحف تتاري حقيقي يكتسح كلّ ما يصادفه أمامه.
عن طبيعة الكُتّاب والشعراء على اختلاف جنونهم أو اتزانهم هم بحاجة لعشِّهم المعزول للكتابة، ولأقلّ نسبة ممكنة من الضّغط الذي يطالبهم بالظّهور والقيام بالتسويق لمنتجهم. هناك مفهوم عميق لدى أغلبهم أن الأدب ليس بضاعة أو سلعة مثل باقي السلع المطروحة في السوق للاستهلاك. ذلك أنّ “سوق الأفكار” يبقى الأغلى على الإطلاق، لأنّه يبني الإنسان من الداخل معنوياً، بالمادّة السحرية غير الملموسة، فلماذا يريد البعض حشره مع تجّار الوهم؟
نعم هناك جانب مضيء لهذا العالم الذي يسير بسرعة جنونية، وهو أنه أخرج كل شيء للعلن، لكن هل يلائم ذلك من تعوّد على تقسيم هذا العالم وفق مقامات النّاس؟
في مثال بسيط يجتمع في بعض البرامج عالم اجتماع وطبيب نفسي ورجل دين ومؤثر وشاعر، كيف يمكن لهذه الطبخة الإعلامية أن تكون منتجة؟ أحد الأصدقاء أخبرني أنّه ظلّ نادما على اطلالته التلفزيونية تلك لأنّ الهدف من البرنامج إثارة الناس بنقاش بيزنطي، وليس الخروج ينتيجة عقلانية لعلاج مشكلة. وهذا ليس كلّ شيء لقد وجد نفسه في مواجهة مع “السلطة الدينية” التي مثلها رجل الدين، ومواجهة فئة شاسعة من الذين لا يعرفون أهمية الشعر في حياتنا، وهي فئات شاسعة تنتفض ضد أي فكرة جديدة، ولنقل إن ما حدث لصاحبنا هو وضعه في فوهة مدفع، فهل سنلومه إن عاد لقوقعته أو ركض بعيداً حيث يمكنه أن يتنفّس الصعداء.
إن فكرة الاستمرار من أجل الاستمرار فقط فكرة قد لن تدمّر الكاتب فقط بل نتاجنا الأدبي القادم. أقرأ ما باح به جورج أورويل ذات يوم لصديقه آرثر كويسلر مشبهاً نفسه بالبرتقالة المعصورة بسبب استنزاف الصحافة له، وأتخيّل بشاعة ما عاشه ويعيشه كتاب آخرون تحت ضغط مطالب لا تنتهي كالتي وصفها قائلا: “يريدون مني أن أحاضر لهم، أن أكتب كتيبات، أن التحق بهذا وذاك….إنّك لا تعرف كم أتوق لأن أكون حرًّا من ذلك كلِّه ويكون لدي وقت للتفكير مرة أخرى” صادف أن كان هنا في قمّة تألقه بعد نجاح كتابه “مزرعة الحيوان”.
أورويل نفسه عبّر عن مأساته تلك في روايته “قليل من الهواء المنعش” متقمصا شخصيته الرئيسية التي تواجه الملل والفراغ وندرة الشّغف وكثرة الأعباء، ثم ذكريات الشباب الذي مضى، وأخيرا المواجهة الوحشية مع التحوُّل الذي لا يرحم للعالم والذي لا يستنزفه حتى آخر رمق ويحرمه حتى من هواء نقي يتنفسه.
لا شيء يدفع الكتّاب والشعراء والمبدعين إلى الجنون إلا تلك الطريقة في تطويقهم ومحاصرتهم بأعمال تأكل وقتهم وطاقتهم دون أي مردود لها، وهو بالضبط ما تبرع فيه وسائل التواصل الاجتماعي دون هوادة.