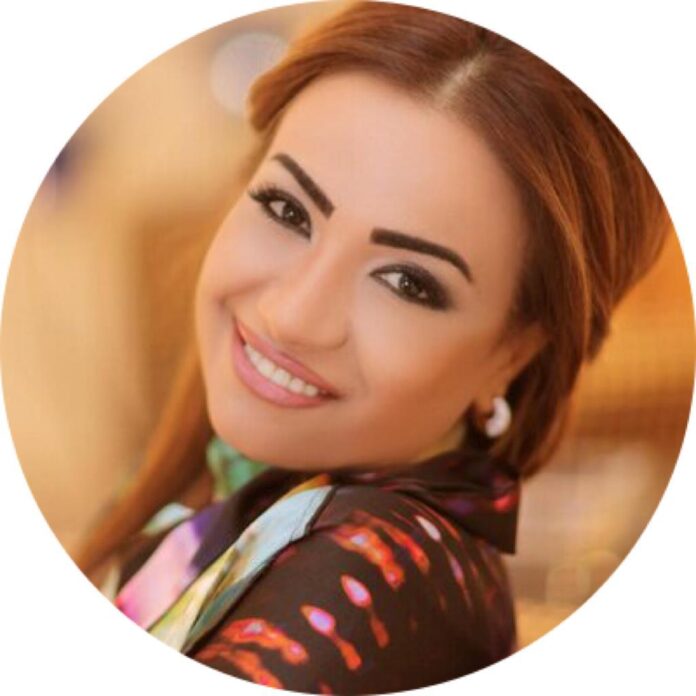إنّه العيد، ومع هذا لا مذاق للعيد في فمي، ثمة شيء افتقدته ذات عمر ولم أعثر عليه مرة أخرى. منذ سنوات أصبحت أعيش رحلة بحث عن العيد الذي ضاع مني. سلكتُ دروبا اختلفت عن دروب من تقاسمت معهم فرحة الأعياد الأولى، وكان قدري بقدر ما أسعدني في أمور كثيرة إلاّ أنّه أخافني في كمِّ الوحدة التي جعلها من نصيبي في أعياد قضيتها لوحدي.
وفي الحقيقة هي أفراح وأتراح عشتها مع أشخاص زجّت بهم الحياة في مساحة حياتي الشخصية دون أن أرغب في ذلك. كما أوهمتني في مرّات كثيرة بدفء يشبه دفء عائلتي، حتى وهبتُ جزءا ثمينا من عمري ومشاعري الصّادقة لهم. ظننت أنّ العطاء سيقابله العطاء لا محالة. لكن قواعد الحياة غريبة، يسهل حين تكون غريبا أن يعاملك الجميع فجأة مثل البطّة السوداء لسبب تافه قد يختلقه أحدهم لشيء في نفسه.
حدث ذلك كثيرا في حياتي، سامحت ومضيت، ففي كل عيد كنت أطوي صفحات من وجع ما وأمضي.
لم تخلُ بعض أعيادي من دموع الشوق للماضي الجميل، ولكن أي جنون هذا الذي يقدّم لنا الماضي كلوحة ممتلئة بالكمال؟ فكل لحظة تمضي هي لحظة لن تعود أبداً، وما عشناه في طفولة دافئة ليس أكثر من مسرحنا الصغير ذي الكواليس التي كنا نجهلها ولا نزال.
المشكلة اليوم أن الأعياد أصبحت باهتة، وجافّة، نتبادل فيها التهاني ببطاقات جاهزة عبر تقنية “الفوروورد” بكبسة زرّ، ترسل البطاقة للمرسل إليه الذي يلقي عليها نظرة سريعة ويرد بالمثل.
كمٌّ هائل من البطاقات السعيدة هطل على الهواتف كلها، ووقت طويل أمضاه كل واحد منّا وهو يردُّ على مراسليه. مجتهدا أن يرسل أجمل البطاقات للجميع. ثم ماذا؟
يلي هذه العملية المنهِكة شعور غريب بالخواء. فالعيد لم يكن هكذا منذ عشرين سنة مثلا، ولا منذ ثلاثين سنة… أو منذ نصف قرن.!
كان العيد يبدأ بعد صلاة العيد، والمعايدات تبدأ عند عودة المصلين إلى بيوتهم، كل شيء يبدو خاضعا لطقوس فرح حقيقي، مقارنة مع معايدات الواتس آب والإنستغرام اليوم والتي تبدأ قبل نهاية شهر رمضان بثلاثة أيام أو يومين.
استغرب هذا التغيّر، وأتساءل إن كانت تقاليدنا الدينية قد تغيرت في ظرف عشرين سنة، ونحن شهود على ذلك، فهل ما وصلنا منذ 1400 سنة ظلّ على نسخته الأصلية؟
أطرح السؤال على العقلاء، والمتمعنين في النصوص، وأترك لهم حرية الإجابة ومحاولة اقناعنا أن ما وصلنا صحيح بالفعل، ولم يتغيّر على الأقل مئات المرّات خلال رحلته الزمنية إلينا.
أمّا عن التغيّرات التي نعيشها نحن فهي كثيرة جدا، وقد روت لي صديقات مغاربيات عن عادة اسمها “حق الملح” أو “حق الطعام” تعتبر من العادات الراسخة في معايدات الرجال لزوجاتهم يوم العيد، فبعد صلاة العيد يكون الزوج قد أحضر هدية من ذهب أو فضة يضعها في فنجانه بعد أن ينهيه ويسلمه لها شاكرا كل ما بذلته من تعب خلال الشهر من تحضير للطعام واجتهاد منها لجعل طاولة الإفطار متنوعة ومليئة بالأطايب، حتى أنها تضطر أحيانا لتذوق الطعام بطرف لسانها مع الحفاظ على صومها دون أن تضعف وتفطر.
هذه العادة نتيجة التواصل الاجتماعي اليوم انتقلت إلى المشرق ثم الخليج مؤخرا، وبدأت تنغرس في ثقافتنا الشعبية ويقال إنها أساسا قدِمت إلينا من مسلمي الأندلس.
تتشكّل ثقافة الأعياد مثل كل الثقافات الشعبية بسبب التأثر بالآخر، وتغيُّرِ الظروف. لم نكن نعرف السهر حتى موعد السحور ومطلع الفجر، كان الصوم عادة صارمة، والشهر له وقاره، ولم نشهد فيه هذه المبالغات في الملذّات الحسية إلاّ في السنوات الأخيرة.
أمّا عنّا جميعا فنحن نحمل عاداتنا معنا، محاولين إحياءها عند حلول كل مناسبة، لكنّنا نفشل في بعض الحالات، منها حالتي الشخصية، حيث يصبح افتقادي للعائلة أكبر عائق لإحياء أي تقليد عائلي سواء في الأعياد أو في غيرها من مناسبات، إذ يصبح مذاق الأشياء بلا طعم حتى وإن مارستها. وهذا ما يجعلني أجتهد كل سنة حتى لا يكون لدي ارتباطات في الأعياد، فأطير إلى البحرين، وأعيش دفعة واحدة أفراح طفولتي وصباي وشبابي بنهم يدهش من حولي أحيانا، ففي النهاية ما اكتشفه خلال كل زيارة هو أن التغيّرات تلامس ما ألفته هناك، فأجد بعض التقاليد مستمرة وبعضها آفل أو في طور الأفول، وهذا يحزنني ولا يحزن من يعيشها، كون بعضها ينجح في البقاء وبعضها الآخر يموت.
ويبدو أن لكل ثقافة عمر معيّن، وكلُّ هذه الطقوس، والعادات تولد وتكبر وتشيخ ثم تموت مع الكبار الذين يحرصون على تناقلها بين الأجيال.
وقد توقفت كثيرا عند السؤال الأكثر احراجا: لماذا نشتاق لثقافة نعتبر جزءاً كبيراً منها السبب في إرهاقنا نفسيا؟ فليس كل ما نَحِنُّ إليه جميلا من وجهة نظرنا!
ربما كلُّ هذا الحنين حنينٌ لعمر الطفولة في كنف العائلة، وما نحتاجه هو تلك الطقوس العائلية التي تشكّل بصمة اختلاف عن غيرها، والتي تحدث في زمن دائري لا ينتهي، عكس الزمن الخطّي الذي يأخذنا للموت.
هناك حيث اللانهاية للحظات الفرح المتكرر أقبع في الأماكن نفسها مستعينة بذاكرة أختي لأعيش مجددا إحساسا فريدا في تفاصيله الجميلة، نخرجه معا من صناديق الماضي ونتركه يضيء ذاكرتنا المشتركة، لكن المؤكّد أن إعادة طقوس متطابقة مع الماضي مهمّة مستحيلة، لأن كل فصل منه ينطوي على خسائر ما، ومن الأفضل ابتكار أنواع جديدة تأخذ الماضي بعين الاعتبار لكنّها تنظر للمستقبل.
لطالما كانت الأعياد مناسبات مليئة بالأحداث العائلية، وقد أُلِّفت قصص كثيرة حولها، ومنها ما تحوّل إلى أفلام ناجحة. هناك أفلام كتبت وأخرجت لتكون جزءا من طقوس الأعياد. على سبيل المثال أرى أن تقبّلنا لعيد الميلاد جاء من إعجابنا بتلك الأفلام، مثل سلسلة أفلام “وحيد في المنزل” الذي حقق إجمالي إيرادات كادت تبلغ ال 500 مليون دولار سنة صدوره العام 1990. وهو فيلم لم يتوقف عند أول نسخة، فقد شجع نجاحه على انتاج عدة نسخ منه آخرها العام 2012، ورغم تفاوت نسبة نجاحها، إلاّ أنها أفلام يفضل الكثيرون إعادة مشاهدتها في الأعياد، خاصة أولئك الذين تجبرهم الظروف على البقاء وحيدين بعيدا عن عائلاتهم. طبعا هذا ليس قاعدة، فالفيلم يتذكّره الناس أيام عيد الميلاد، ويبدو أن الكبار يحبونه أكثر من الأطفال والمراهقين.
بالنسبة لنا أذكر إلى زمن قريب ارتباطنا بمسرحية “مدرسة المشاغبين” في فترات العيد، لأنها كانت تبَثُّ في أماسي أول أيام العيد، وتتبع بمسرحية “العيال كبرت” في ثاني أيامه، أو “شاهد ما شافش حاجة” …
أمّا صور العيد، فتلك حكاية أخرى، حين نقف وقفتنا التّاريخية تلك بألبستنا الجديدة، وأنفاسنا المقطوعة حتى لا تفسد أي حركة صورنا.
لا مفرّ من عقد مقارنات مع الماضي كلما حلّت الأعياد علينا. فالماضي رغم ابتعاده عنّا زمنيا، إلاّ أنه لا يزال ملموسا، نتحسّسه بكل مشاعرنا، وحتى الصور بالأبيض والأسود نتحسَّسُها بحب ونحن نتأمل ما تحمله من ذكريات، فيما يخوننا الحاضر رغم هواتفنا الذكية التي صوّرنا بها آلاف الصور، وأكثرها اختفى لأسباب تقنية محضة.
إن قلت الآن أن لا نكهة للعيد، فالأمر نسبيٌّ بالتأكيد، فلكلّ عيد نكهة، حتى حين نقضيه وحيدين، تهجم علينا كل الأعياد القديمة وتحوّل وحدتنا إلى صخبٍ استثنائي.