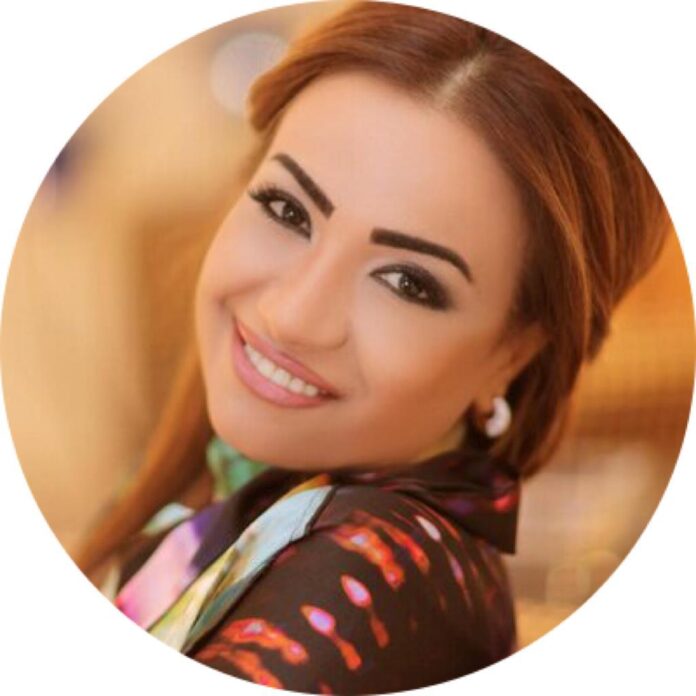الرجل الذي انطفأت أنوار عينيه وهو طفل عاش صدمته لوحده، وأصبح عليه أن يعيد تشكيل عالمه بطريقة افتراضية تبقي تلك الأنوار مضاءة لباقي حياته مهما طالت، ولعل نجاحه يكمن هنا، حين عرف طريق النور، ومضى فيه ساحبا خلفه نخبة النخبة ليس في مصر فقط، بل في العالم العربي كاملا.
أما كيف فُسرت كل أفكاره التنويرية في ما بعد، فتلك لم تكن يوما مشكلته، بل مشكلة المتلقي العربي بكل أنواعه وهو يتعرض لأكبر عملية هتك للعقل شهدتها الحقبة المعاصرة. والدليل أن أغلب الردود على طه حسين لم تكن فكرية، بقدر ما أخذت منحى شخصيا لم يتوقف إلى يومنا هذا عن طعنه في أمور لا يعلمها إلا الله وحده.
وكلما تقدم بنا الزمن برز مهاجمون له ومدافعون عنه، لكن مدار الهجوم والدفاع ظل نفسه وهذا يعني أننا لا نزال عالقين في المكان ذاته منذ أطلق طه حسين كتابه «في الشعر الجاهلي». مات طه حسين ولم يقف أحد في وجهه فارِدا أمامه أدلة تكسر ما طرحه من أفكار، بل ظل يُلاحق مثل متهم حتى قيل إنه تراجع عما قاله، فعدل الكتاب في طبعاته التي تلت الأصلية، وبرزت قصص كثيرة تثبت إسلامه، وتمنحه «شهادة حسن سلوك» مثل قصة مدح الشيخ محمد متولي الشعراوي له، احتفاء بزيارته للأراضي المقدسة، وهي تضع عميد الأدب في بوتقة ضيقة متناهية في الصغر تقزم حجمه الفكري وتهينه أيما إهانة.
في كتابه «طه حسين، وثائق مجهولة» الصادر عن منشورات بتانة ينشر إبراهيم عبد العزيز قصيدة الشعراوي كاملة بخط يده على الغلاف الخلفي للجزء الرابع المخصص للرسائل العائلية وأشياء أخرى، وهو في الأجزاء الأربعة يأخذنا في رحلة إلى أعماق وشواطئ حياة عميد الأدب العربي على مدى 2200 صفحة (أربعة أجزاء ضخمة) جامعا مقالات وشهادات ممن تتلمذوا على يديه وعاشروه وعاصروه، ووثائق وصور تضيء حياته التي ربما غابت عن كثيرين منذ كان في قلب الحدث العلمي والثقافي حيا يرزق إلى هذه اللحظة. لكنه أيضا منحنا فرصة تذوق مرارة فراقه، وجعلنا نشهد جنازته المهيبة، وعذابات زوجته التي عاشتها بعد غيابه، وصحح الكثير مما ورد بشأنها، مبررا ما تم تفسيره بأنه قسوة وعنصرية ورفض للمحيطين به. فقد اهتمت به اهتماما بالغا، ولم تكن تسمح بأن يخرج إلا وهو في كامل أناقته، وسهرت على مدى عمرهما معا على توفير كل ظروف الراحة ليعمل ويفكر ويرتاح.
لا يفارقنا الشعور بأن إبراهيم عبد العزيز كتب سيرة العميد وهو يقف في جانب المدافعين عنه، مذكرا بمكانته العلمية ومواقفه الإنسانية. نقرأ في الجزء الرابع «ويبكي سكرتيره وهو يقول: لقد اكتشفت خلال عملي معه في العامين الأخيرين قبل وفاته، أنه رجل مؤمن لم يعرف اليأس، وأنه لم يكن يحقد على أحد ولم يحمل ضغينة لأحد». كما يورد رواية عن ابنه مؤنس يحكي فيها أنه وجد مصحف والده بعد وفاته مفتوحا على الآية «ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله». ولا أدري هل يهمنا فعلا إيمان الرجل بعد أن صار عند ربه منذ نصف قرن، وهل يحق لبشر أن يحاكمه في إيمانه، هو الذي يُصَنف من أهل العلم، وتركته العلمية أكثر أهمية بالنسبة لأهل الحياة الدنيا، من مناقشة إيمانه وأمور لا يمكن إثباتها حتى لو اعترف صاحبها بها. يجمع المؤلف ما أمكن من أرشيف قديم ويضعه تحت الأضواء عسى أن تنقشع عتمة دهاليز بداية هذا القرن، وتكف الغوغاء ربما عن ملاحقة الرجل إلى قبره بالتهم، ويا للصدف فخبر الإقبال على هدم المقبرة التي دفن فيها عميد الأدب لأسباب عمرانية محضة، تضعنا أمام هول مصيبتنا وانغماسنا في تجهيل الإنسان، رغم الإنكار الذي رافق انتشار الخبر كالنار في الهشيم.
ينشر المؤلف نسخة عن الحوار الذي أجراه الشاعر كامل الشناوي مع طه حسين بعد عودته من الأراضي المقدسة في الجزء الثالث من الكتاب، معنونا بـ”طه حسين يناجي ربه، أنت إلهي.. لا إله إلا أنت!”، وفي المقدمة يؤكد الشناوي أن طه حسين قبّل الحجر الأسود، وفي المسجد الحرام ناجى ربه، ولم يكن الوحيد الذي اهتم بهذه الزيارة فقد كانت حدثا ضخما له «طنة ورنة» كما يقال، وهي في قراءتي الخاصة كانت أشبه بإعلان «توبة المرتد» منها إلى إثبات إيمانه، وكلاهما لم ينصف طه حسين الفقير، الكفيف ونضاله الطويل لإثبات ذاته وبلوغ أعلى مراكز العلم والمعرفة، وصراعه مع المبصرين الذين أعلنوا عليه الحرب من حيث لم يتوقع لتعطيل مساره.
التهم التي وُجهت لطه حسين لم تتوقف عند الطعن في إيمانه، بل تجاوزتها إلى الطعن في وطنيته، في الباب الثالث من الجزء الثالث يجيبنا المؤلف عن الأسئلة الكثيرة التي طرحت عنه، هل كان يعمل لحساب الغرب، أم لحساب المسيحية، أم لحساب الشيوعية أم لحساب الماسونية، أم لحساب اليهود؟ وجيد أنه عاد لأصل الحكاية ليوضح أن خليط التهم ذاك كان سببه ممول مجلة “الكاتب المصري” الذي كان يهوديا، وكان نشاطه كأي نشاط آخر لليهود في مصر كونهم كانوا مسيطرين على شؤون المال، ونقرأ في هذا الفصل الكثير عما نجهله اليوم عن اليهود في مصر قبل قيام ما سميَ في ما بعد بالدولة الإسرائيلية، وهي فترة تلت تأسيس العميد للمجلة وانتشارها بسنوات عديدة.
طُعٍن الرجل أيضا في حبه لزوجته “الخوجاية” فقيل إنه أغرم بالكاتبة سهير القلماوي، منذ تعرف عليها وهي بعد تلميذة في الثامنة عشرة يسعى والدها لإلحاقها بالجامعة كأول طالبة جامعية في مصر، ورغم شهادات كثير تؤكد هذه الحكاية، ومنهم تلميذها عبد المنعم تليمة الذي عرفته بنفسها على طه حسين، إلا أن الحكم على الحب يشبه تماما الحكم على الإيمان، ودون أدنى شك يبقى مسألة يلفها الغموض لأنها تخص الشخص نفسه.
يحفل الكتاب بحكايات طريفة أيضا، مثل تلك التي رواها تليمة نفسه كشاهد على صداقة طه حسين بالرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة، منذ كان لاجئا سياسيا في مصر، وكان يجلس في مقهى فقير جدا مع زكريا أحمد، وبيرم التونسي، وعلي أحمد باكثير، وحين يمر عليهم بائع الفول يشتري كل منهم رغيفا بتعريفة. يقول بعد أن أصبح بورقيبة رئيساً وزار مصر قال لجمال عبد الناصر: “أنا عاوز أشوف الواد طه” فقال له عبد الناصر: “اعطنا اسم هذا الولد لنرسل له عن طريق سكرتارية ديوان رئاسة الجمهورية ويجيئك فورا” فقال له بورقيبة: “ديوان إيه…هذا الرجل له مقام رفيع، أنا من يجب أن أذهب إليه، إنه طه حسين، الرؤساء هم من يقصدون العلماء”. وشاءت الصدف يومها أن يزوره يوم أربعاء وفقا لجدول البرنامج الرئاسي، وهو يوم محاضرته الأسبوعية، فاعتذر من طلبته ثلاث مرات، بتكليف سهير القلماوي بإيصال اعتذاره للطلبة، وتكليف سكرتيره الخاص فريد شحاتة بكتابة اعتذار على اللوح ثم اعتذاره شخصيا منهم في الأربعاء الذي تلاه.
على غرار المصريين المتمكنين من سرد “الحواديث” يسرد إبراهيم عبد العزيز حكاياته عن طه حسين، ويبدو جليا أنه ليس فقط خبيراً في كتابة السيَر الذاتية، بل خبيرا فيما يحبه القارئ العربي ويجعله لا يمل. فالكتاب رغم حجمه الضخم جدا وعدم التزامه بمنهج، إلا أنه ممتع حتى في جزئيه الأول والثاني، وما يتعلق بملفه الشخصي في كلية الآداب، ومعاركه بشأن استقلال الجامعة، والدفاع عن اختلاط الجنسين في حرمها، وعن خلفيات انشائه لجامعة الإسكندرية، ثم بمحاضراته النادرة في جامعة فؤاد الأول عام 1938، قدم منها تسعا وعشرين محاضرة في الأدب العباسي كان قد دونها تلميذه حامد عبد المجيد بخط يده وأهداها لأستاذه، ومحاضرات أخرى متفرقة.