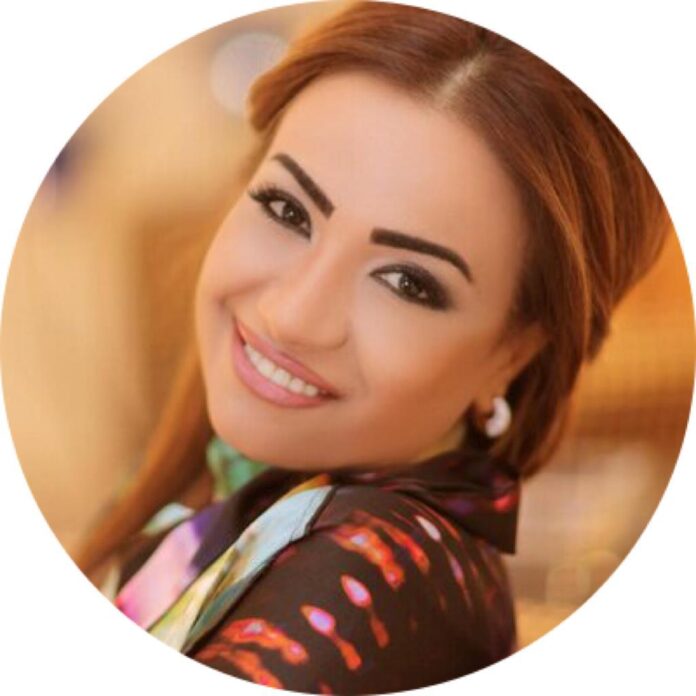عاشت النساء محلّ نقد وانتقاد على مدى قرون من الزمن، وقد اُعتُبِر ذلك نوعاً من السلطة التي مارستها المجتمعات الذكورية عليهن، ما جعلهن يحتجن لكثير من الوقت لنيل شرعية تسمح لهن بممارسة النقد وإعطاء رأيهن فيما يحدث لهن وحولهن في الشؤون كلِّها بدءا بما يرتدين من ملابس إلى طريقة عيشهن. على سبيل المثال إلى بداية القرن العشرين كانت النساء يمنعن من دخول المكتبات في حال حظين بالتعليم من طرف عائلاتهن.
وصول المرأة إلى عتبة الثقافة مثلا لزم كفاحاً طويلا، وقد امتدّ التحكم في تطوّر فكرها إلى مطلع القرن العشرين، وكانت النساء القلائل اللواتي أُفلِتن من تلك الأحكام الظالمة، لسن أكثر من حالات شذّت عن القاعدة. وقد شهدت الفضاءات الثقافية مخاضات عصيبة لولادة نساء من الأدب كون الأمر ارتبط مباشرة بقوّة الكلمة وما قد تحدثه من تغيرات في المجتمع كله لهذا كان التفضيل لقمعهن مريحا للجميع.
وإن كان هناك من يعتبر البدايات الشحيحة للنقد النسائي أمرا ذا شأن، فإنه في الوقت نفسه يفتقر للمستندات، كل ما ورد في الكتب يمكن تلخيصه في حكايات عمّا تمت صياغته شفهيا في صالونات أو مجالس حضرت فيها نساء مستمدّات سلطة الحضور فيها إمّا بسبب ثروتهن، أو دعم ذكوري لهن، قد يكون متمثلا في الأب أو الزوج أو العشيق، وقد ظلّ هذا الدعم موجودا منذ تلك الأيام إلى لحظة كتابة هذه الأسطر، رغم أن الجامعات أثمرت بكثير من الأسماء الأدبية والنقدية ليس فقط في العالم الغربي ولكن في العالم العربي أيضا.
لكنّ بدايات النقد النسائي وفق تصوُّري الخاص كانت تسترشد بإحساس المرأة وانطباعاتها المتواضعة والتعبير عن نفسها، بعيداً تماماً عن الأفكار العميقة. وهذا ربما يجعل البعض يتوقفون عند تلك المرحلة لنبذ موهبة المرأة الفكرية لخوض مجالات أكاديمية مهمة مثل مجال النقد. فكانت التهمة المنتشرة على مدى عدة قرون هي أن “المرأة عاجزة عن التفكير”، إلى أن كتبت فرجينيا وولف مقالها الطويل “غرفة تخصُّ المرء وحده” العام 1929، والذي لخّصت فيه كل العراقيل التي تجعل العملية الإبداعية صعبة على المرأة.
وفق وولف الموهبة ضرورية لكنّها ليست كافية أبدا لولادة مبدعات في كل المجالات خاصة الكتابة، فالمرأة المبدعة بحاجة لمساحة ذهنية نظيفة لا تحتكرها احتياجات الآخرين، تماما كما تحتاج لاستقلالية مادية تطلق سراحها من معتقل المُعيل الذي يطالبها دوما بخدمات لا تنتهي.
وعلى كل وإن كانت تلك مرحلة عبودية طويلة إلاّ أنها شهدت أحداثاً كثيرة جعلت وعي المرأة يتطور شيئا فشيئا، فحتى وإن عُزِلت عن عوالم الرجل إلاّ أنها على المدى الطويل تأثّرت بنتاجه الفكري، كما تأثرت بسلوكه أيضاً، لكن حدث أيضا أنّها كانت مؤثّرة على رجال تمكّنوا من فهمها ومعرفة قيمتها خارج إطار الجسد الذي اختصرها إلى “آلة حية منتجة للمتعة” لا غير.
ترى ماذا كان ينتظر العالم من الأنثى التي يتم توجيهها منذ نعومة أظافرها إلى أشغال البيت، وتهيئتها للزواج؟ من المنطق أن ندرك أن ذلك كافيا لإخفائها حيث لا يمكن لها الظهور بغير عباءة الخضوع لقواعد عملت على وقف تدفق أفكارها إن خالفت المسار المرسوم لها. بعض النساء اللواتي خلعن هذه العباءة اُتُّهِمن بالسمعة السيئة لأنهن لم يحترمن الأعراف والموروث الديني. هذا المصير الذي عاشته نساء الغرب، نعيشه بحذافيره اليوم مع استثناءات قليلة لا تتناسب مع جحافل المتخرجات من الجامعات العربية كل سنة.
والآن لنكن صرحاء مع أنفسنا ونطرح أسئلة شجاعة على نسق: ماذا قدّم حق التصويت للمرأة في مجتمعات تدين كل شيء للرجل؟ وفي الشأن الثقافي ما هي مساهمة المرأة في انتاج الخطاب النّقدي في مجال الأدب والفنون؟ من المؤكّد أن النسويات “المتشدّدات” هن اللواتي استخرجن جثث عدد كبير من المبدعات من قبور النسيان، وصحّحن التاريخ الذي قام بإخفاء أو إهمال نساء ناضلن من أجل عدالة إنسانية تضمن للمرأة حق التعبير عن الذات والعيش بكرامة. من المؤكّد أيضا أن استيعاب النساء للخطاب التفاضلي الذي صاغه الرجال يشكّك في الدور الذي تلعبه الكاتبات، أمّا مسألة وصول المرأة إلى الخطاب النقدي فقد صُنِّفت كمسألة مصداقية، إلى اليوم تعتبر إسهامات المرأة شحيحة جدا في نظريات الأدب، وهذا ما يمكن تسميته بتقليص تواجدها في حدود السلطة الفكرية الفعّالة.
أود أن ألفت نظر القارئ إلى الصلة بين حق التصويت الذي تمارسه النساء للتفضيل بين رجل وآخر للتربع على عرش السلطة، وبين الأحكام النقدية التي تضع الأدب “النِّسوي” في خانة و “النّسائي” في خانة بعيداً عن الكلّ الجامع للأصناف الأدبية! وبودّي اليوم أن أطرح سؤالاً أكثر جرأة: في أي مأزق تقع سلطة النّقد أمام انهيار الفروقات “الجنسية” بين المبدعين والنقاد بولادة الجنس الذي لا جنس له، أو بشكل أوضح ما نعني به المرأة التي ليست امرأة تماما والرجل الذي ليس رجلا تماما؟ هل يمكن للمعطى الإبداعي والنقدي أن يتغيّر؟
إذ يبدو أنه خلال بطئنا في استيعاب ما انتجته جامعات الغرب نظريا حول المفاهيم آنفة الذكر – ونحن التابعون دائما لها – داهمتنا التغيرات البيولوجية التي عصفت بالكائن البشري وعاقبته على تطرّفه وظلمه، حتى أصبحنا نسمع اليوم من يردد أن نسويات السبعينيات أكثر رحمة مما نعيشه ونحن نواجه ظاهرة “المثلية” التي حرّرت العقل من سلطة الجسد، لكن فورتها عالميا تضعنا مجدّدا أمام مفترقات طرق صعبة، إذ لطالما كان الجسد واجهة لأي نتاج أدبي أو نقدي نتعاطى معه، حتى أن إسقاطات نقدية تحمل إيحاءات جنسية كنّا نتقبلها على مضض ظنّا منا أنها صادرة من نقّاد عارفين، مثل استعمال مصطلح “فحول الشعراء” و”عقدة القضيب عند الشاعرة فلانة” و”شاعرة ذات فرج مبتور” وما إلى ذلك من المصطلحات الذكورية العنصرية التي بالغت في جعل منصة النّقد منصة لجلد الأنثى، وتجريدها حتى من مكتسباتها الأدبية لا أعتقد أنّها لامست روح النصوص بقدر ما شوّهتها باسم “سلطة النقد”. لقد كانت وولف أكثر إنصافا لبنات جنسها حين تحدّثت عن الغرفة الخاصة بها من أجل الكتابة، وأعتقد أننا لا نزال على مدخل تلك العتبة مصدومين بما سيحدث مستقبلا. نحن أمام خيارات أن نمضي في طريق التبعية أو نخرج تماما من المشهد الثقافي العالمي وما يترتب عنه من رؤية نقدية جديدة للآثار الأدبية والإبداعية التي تنتجها أدمغة لا “جنس” لها.
من حقنا هنا إذن أن نحصل على إجابات عن أسئلتنا، ماذا حققنا كنساء؟ وإن لم نحصل على أي جواب كما ألفنا، فمن حقنا أن نعيد صياغة نفس الأسئلة بطرق مختلفة قبل نهاية القرن الحالي وبعده والمطالبة بتجاوز النقطة صفر التي نقف فيها منذ قرن على الأقل.
ثمة حقائق يجب الاعتراف بها والتأمُّل فيها، والاستيقاظ من وهم أننا نملك حركة نسوية على سبيل المثال، ونقصد هنا حركة ناقدة تطرح أفكارا للنقاش دون خوف من “سلطة المثقف الذكر” الذي لا يتردّد في قطع رأس أي أنثى تفكّر فعلا، راغبة في استقلال وانفصال كاملين عن امبراطوريته التي يتحكّم فيها وفق منظوره الضيق للمرأة.
أكثر من اسم لناقدات عربيات، يشاركن لتلوين ملتقيات النقد والأدب بألوان زاهية في محافل أقرب للترويج السياسي منها لمناقشة الأفكار، فمن الناقدة التي يذكر اسمها مثلما تُذكر إيما غولدمان أو فرجينيا وولف (مطلع القرن العشرين) أو سيمون دي بوفوار لاحقا، أو آني إيرنو الحاصلة على جائزة نوبل مؤخرا؟
قد تكون الإجابات مفيدة لي ولكم إن توفّرت!