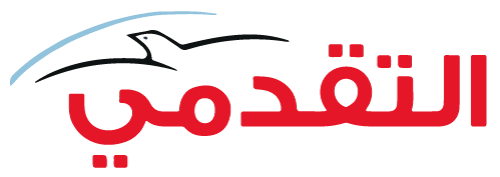الشاعر علي الستراوي يؤكِّد: مع مشاعر الاغتراب يتشكَّل الألم بصورة إبداعٍ جديد
لم تُجانب بصيرة الأديب والفيلسوف العالمي “نافوليس” الصواب حينَ قال: «الشعر يداوي الجراح التي يُحدثها العقل»، ففي عالمٍ بات رازحًا تحت وطأة التفاصيل اليوميَّة الماديَّة؛ يأتي الشِّعرُ مُرممًا مشاعر الإنسان المُنهكة من صِراعاتها مع الواقِع، ما يجعل منهُ اختيارًا موفقًا على جدول برنامج “مركز عبدالرحمن كانو الثقافي” في مُستهلِّ برنامج أنشطة الفصل الأوَّل لموسمه الثقافي الثلاثين الذي افتُتحَ بأمسيةٍ شعريَّة للأديب والإعلامي “علي الستراوي”.
مُمسكًا بدفَّة إدارة الأمسية كانت للشاعر/ علي النهَّام كلمتهُ التي قدَّم فيها نجم الأمسية الشعريَّة بقوله: “معنا اليوم شاعرٌ يبتكرُ القصيدة ابتكارا، يؤنسنُ الشِّعر، وما أقلّ الشعراء الذينَ يؤنسنونَ الشعر! عندما تقف على شُرفةِ قصيدتهِ تُشاهدُ في مداها كُل تفاصيل الحياة البحرينية، تُشاهدُ النص مُلتصقًا بالأرض، ممزوجًا بالماء، مُضمخًا بالتراث والتاريخ والعادات والتقاليد، مُضمخًا بما يفعلهُ الناس من حوله.. علي الستراوي عندما يكتبُ للحبيبةِ لا ينسى الوطن، فلا تُميز أحيانًا بين الحبيبة المرأة، والحبيبة الوطن، والحبيبة القصيدة أيضًا. شاعرٌ مُخلصٌ لقصيدتهِ، مُخلصٌ لقلمه، رسالتهُ الإنسان والحُب والوطن والجمال. من يُتابع نتاجهُ الأدبي سيُلاحظ أنهُ يتجدد في كُل إصدار، ويُطوّرُ من أدواتهِ ولا يُكررُ نفسَه إلا بالرسالةِ والهدف وبعض التحليق.. إنهُ شاعر وكاتب وإعلامي وروائي، مُشرف تحرير المُلحق الثقافي بجريدة أخبار الخليج البحرينية، يكتُب الشعر الفصيح والنبطي، وله كتابات في مجال القصة القصيرة وأدب الطفل، بدأ عمله عبر نافذة الصحافة منذ عام 1992م، صدر لهُ باقة من الإصدارات منها: “المرافئ المُتعَبَة- 1995م”، “فضاء- 2001م”، “على راحة قلبي- 2008م”، “امرأة في ضيافة القلب- 2014م”، “النديد- 2018م”، “فصول لسيرةٍ واحدة- 2019م”، “خاصرة الريح – 2022م”، “ذاكرة الماء- 2024م”، كتبَ في صحُف خليجيَّة وتُرجمَت بعض نصوصه إلى اللغة الإنجليزيَّة ولُغات أُخرى..
انتقلَ زِمام الحديث إلى الشاعر علي الستراوي ليقول: “الشعرُ ليسَ وليدُ لحظةٍ بل وليدُ سنوات، وكلما مرَّت السنوات وامتدَّ بالشاعر العُمر يرى نفسهُ بحاجة إلى تطوير أنماط جديدة من شكل القصيدة، لقد أشارَ الشاعر علي النهام إلى ومضة من تجربتي الشعريَّة؛ لكن لنبدأ الآن بخوض بحر هذه التجربة معًا بقراءتي بعض تلكَ النصوص”.. أنصتَ الحاضرون لنُخبةٍ من نصوصه الشعريَّة التي رافقها شيء من نثر التساؤلات والردود بينٍ حينٍ وآخر للتعريف بالشاعر ومسيرته الإبداعيَّة وتقريبها من الجمهور، إذ سُئِلَ عن حقيقة انحيازه للقصيدة الفصيحة التي احتلَّت صفحات مُعظم إصداراته الأدبيَّة؛ فأجاب أن تجربتهُ الشعريَّة بدأت فعليًا منذ عام 1973م؛ لكنهُ كتب نصّهُ الفصيح الأوّل خلال ثمانيات القرن العشرين، ومرَّ بمُختلف المدارس الشعريَّة حتى رسَت سُفُن تجربته على شواطئ قصيدة النثر، ولم يطبع مجموعات شعره العامّي (النبطي) حتى الآن لأنهُ يرى أن الشعر الفصيح هو مشروعه الأوَّل.. وعن سر حضور رمزية الماء وقيمته كدلالة واضحة في أغلب نصوص مجموعاته الشعريَّة ولاسيَّما مجموعة “ذاكرة الماء”؛ أفصحَ عن أن كونه ابن قرية “البلاد القديم” الثريَّة بعيون المياه كان سببًا في اختزان ذاكرة طفولته صور السيدات اللواتي يخرجنَ بأطفالهن منذ الصباح الباكر بأوعية جلب الماء فوق رؤوسهن، إضافةً إلى أن التصاقه بوالدته خلال مرحلة الطفولة جعل من الذهاب معها إلى منابع المياه تجربةً يصعُب نسيانها رغم مرور الأعوام، وصار يرى في الماء وطنًا من دونه لا وجود للإنسان.
أمَّا عن إصداره “فصول لسيرة واحدة” فقد اعتبره تجربة تُركز على مشاعر الاغتراب، وأوضَحَ قائلاً: “مع مشاعر الاغتراب يتشكَّل الألم بصورة إبداعٍ آخر جديد، فكل مشاعر الألم التي تستولي عليكَ بسبب الاغتراب تنبثق كبراعم من الفرح والنور والتلاقي والانتظار.. إن هذا الإصدار تجربة لواقعٍ عشته سنوات، لكنني أراها بحاجةٍ لمزيدٍ من التوسُّع عبر نصٍ روائي”.
وعن سؤال: “أيهما يُضيف للآخر؛ الصحافة تُضيف للشعر أكثر أم العكس؟”؛ كان جوابهُ أن الوظيفة الصحفيَّة قد تكون أحيانًا مقبرةً للإبداع، لها وجهٌ مُشرق وهو قدرتها على جعل الإعلامي قريبًا من الناس لأنهُ نبضهم وصوتهم، لكنها تتسبب باختلاق مُشكلاتٍ وحروبٍ ضد المُبدِع على ما يُمكن اعتباره مُجرَّد تفاهات.. وبعودة ذاكرته إلى أيَّام بدايات الانفتاح الإعلامي بعد عام 200م يرى أن كثيرين تعمّدت أقلامهم التربّص به ومُهاجمته بعُنف، لكنهُ استثمرَ مُعاناة تلكَ المرحلة ليصبّها على الورق في صورة نصوص شِعريَّة مؤثرة.
أمَّا عمَّا أضافتهُ ترجمة نصوصه لسيرته كمُبدِع؛ أعربَ عن أن أهم مُميزاتها تعريف الشعوب الأخرى بوجود هذا المُبدع وإطلاعهم على نماذج من أعماله؛ لكن على صعيدٍ فني قد لا يخدم هذا النص الشعري ما لم يكُن الناقل مُترجمًا مُبدعًا ومُتمكنًا قادرًا على إيصال فكرة الشاعر بأمانة للقرّاء، وأضاف: “لطالما استمتعنا بقراءة أعمال سرديَّة لادباء غير عرب بفضل الترجمة الممتازة، منهم همنغواي، مكسيم غوركي، إيميل زولا، فالعمل السردي إذا نُقل بمهارة وموهبة أديب تتذوقه بسعادة.. من منَّا لا يسعد بقراءة أعمال الروائيَّة شارلوت برونتي لأنها تُرجمَت بأيدٍ قديرة، لكن في الشعر قد لا نُصادف ترجمة جذّابة إلا بعض ترجمات رُباعيَّات الخيَّام لأن مُترجميها شُعراء منهم الشاعر إبراهيم العريّض”.