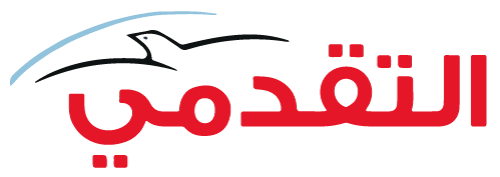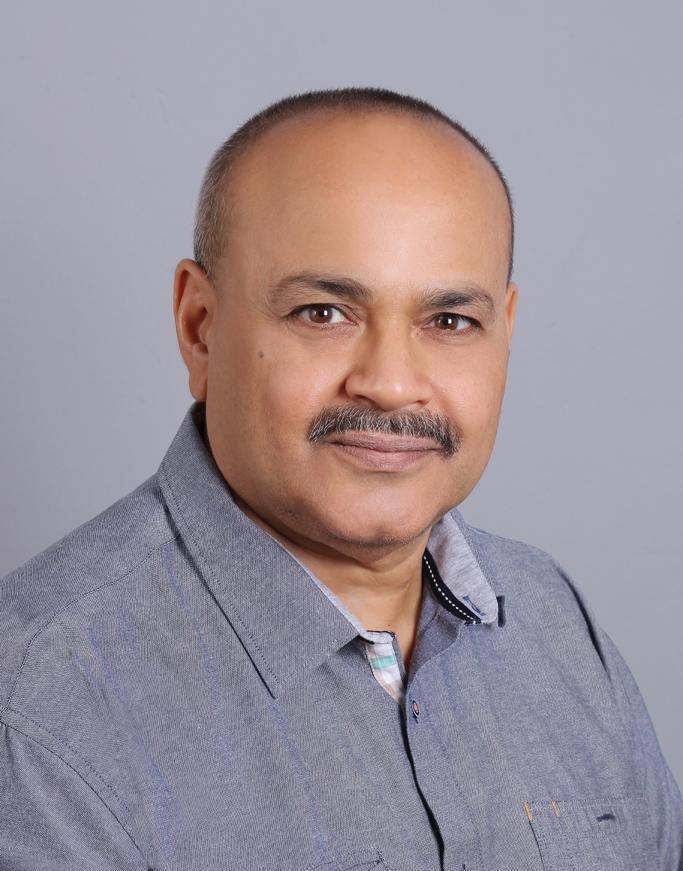محمود درويش في باريس
كانت محطة باريس المحطة الأطول في سلسلة المدن التي عاش فيها درويش: حيفا (عشر سنوات)، القاهرة (سنتان)، بيروت (عشر سنوات)، باريس (أربعة عشرة سنة)، رام الله/عمّان (إثنا عشرة سنة). تنقلاته المستمرة جعلته يعيش في “أكثر من خمسة وعشرين بيتاً. لا بيت لي، ولا عنوان لي”، كما قال في إحدى رسائله إلى سميح القاسم.
بعد خروجه من بيروت مكنته “الصدمة العربية” من التحرر من أوهامه، وحسب تعبيره: “أصبحت ساخراً أسأل أسئلة عن الحياة مطلقة لا مجال فيها للأيديولوجية القومية”.حين حطّ رحاله في باريس كان في مطلع الأربعين من عمره، شاعراً متمكناً من أدواته الفنية، واثقاً من وضوح رؤيته في الحياة، يتقدّ حماساً لممارسة إبداعه الشعري والفكري. ولكن باريس كانت أكثر من مجرد منفى، أو مكان للإقامة. باريس آنذاك كانت زمناً مختلفاً عن ما نعرفه عنها الآن. كان عقد الثمانينات هو عقد سيطرة اليسار الفرنسي ممثلاً بالحزب الإشتراكي الفرنسي على مقاليد الحكم برئاسة فرانسوا ميتيران. من ضمن ما وسم فترة حكمه آنذاك، بيئة الانفتاح الثقافي المميزة، ما دفع درويش للقول في إحدى مقابلاته بأن باريس تعتبر “أجمل مدينة في العالم. ولها من المزايا أنها تجمع أكبر عدد من المثقفين المنفيين في العالم. باريس احتضنتني، وأعطتني الكثير، أكثر اللغات التي ترجم إليها شعري هي الفرنسية.”
في إحدى مقابلاته التلفزيونية قارن درويش تطوّر مسيرته الشعرية بتعاقب الفصول الأربعة. ففي حين شبّه مراحل حيفا والقاهرة وبيروت بفصلي الصيف والربيع في شعره، فإن “باريس هي فصل الخريف في حياتي الشعرية “، حسب تعبيره، وأضاف: ” باريس تُرغمك على النطق، ينهمر الشعر هناك كأوراق الخريف..لا أريد لهذا الخريف أن ينقضي، فهو فصل يلتقي فيه الشباب مع الحكمة، تلتقي فيه الطفولة مع التأمل الحكيم.” في قصيدته “يحقّ لنا أن نحبّ الخريف”، يقول: “نحن، يحقّ لنا أن نحبّ نهايات هذا الخريف، وأن نسأله أفي الحقل متسع لخريف جديد…خريف ينكس أوراقه ذهباً … ياليتنا عشبة مهملة لنشهد ما الفرق بين الفصول.”
في باريس أصدر المجموعات الآتية: “ورد أقل” (1985)، “هي أغنية .. هي أغنية” (1986)، “أرى ما أريد” (1990)، “أحد عشر كوكباً” (1992)، “لماذا تركت الحصان وحيداً” (1995)، ونصف قصائد “سرير الغريبة” (1999)، بالإضافة إلى كتب نثرية: “في وصف حالتنا “(1986)، “ذاكرة للنسيان” (1987)، “الرسائل مع سميح القاسم” (1989)، “عابرون في كلام عابر” (1991).
شعر درويش، شعر موسيقي بامتياز، و يمكن تشبيه دواوين مرحلته الباريسية بالأعمال الموسيقية الكلاسيكية من منظور تنوّع أساليبها ، فقصائد ديوان “ورد أقل” (حوالي خمسين قصيدة) تشبه قالب السوناتة الى حد كبير. أجمل قصائد الحب كتبها في باريس. يقول درويش: “إن القدرة على الحب، شكل من أشكال المقاومة. إذا كتبتُ قصائد حب، فإنني أقاوم الظروف التي لا تسمح لي بكتابة قصائد الحب”.
في القصائد الباريسية المبكرة يمكن تلمس مزاج درويش المتفائل والمحب للحياة. في قصيدة “ونحن نحبّ الحياة” سيصبح السطر الأول منها الأكثر شهرة لدى القراء: “ونحن نحّب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا/ ونرقص بين شهيدين نرفع مئذنة للبنفسج بينهما أو نخيلا”. وفي قصيدته “سماء لبحر” يقول: “أفي الأرض غير السلام؟ أفي الناس غير المسرّة؟ إني أصالح نفسي/ أفي مثل هذا اليوم تموت عصافير فضية هل يموت أحد!! .. يحطّ الحمام على شارة العسكري، وتفلت عاشقة من فتاها لتأخذ قطعة شمس”. الجميل أن عبارة “يحطّ الحمام ” ستصبح قصيدة فيما بعد يقول فيها “يطير الحمام .يحطّ الحمام ..أعدي لي الأرض كي أستريح ..فإني أحبك حتى التعب …صباحك فاكهة للأغاني …وهذا المساء ذهب.”
في باريس كتب قصيدته الشهيرة “على هذه الأرض”: “على هذه الأرض ما يستحق الحياة: على هذه الأرض سيدة الأرض، أمّ البدايات أم النهايات. كانت تسمى فلسطين.صارت تسمى فلسطين.”
في أواخر عام 1984، عقد درويش قرانه على حياة عصام الحيني (مترجمة مصرية تعمل باليونسكو في فيينا) وعاد إلى باريس. لم يعمر زواجه الثاني كثيراً، بل كان أقصر من زواجه الأول. في إحدى حواراته قال درويش عن زواجه الثاني وطلاقه: “لم نصب بأي جراح، انفصلنا بسلام…ولن أتزوج مرة أخرى. إنني مدمن وحدة.” علاقته بالزواج تشبه علاقته بالتنظيم السياسي: ملتبسة، بدايتها شغف، ونهايتها فتور بدون عداوة.
لم تكن سنين باريس كلها أفراحاً ومسرات. في أواخر يناير 1984 داهم الموت صديقه الشاعر معين بسيسو فجأة في أحد فنادق لندن، ولم تكتشف وفاته إلا بعد يومين، لأنه كان يضع على باب غرفته عبارة “الرجاء عدم الإزعاج”. شكّل ذلك الحدث صدمة نفسية لدرويش الذي ربطته بمعين صداقة قوية. في إحدى مقابلاته لاحقا قال درويش بأنه خاف من الطريقة التي توفى فيها بسيسو: “أخشى هذه اللافتة! كلما نزلت في فندق لا أضع هذه الاشارة على الباب. ولا أخفيك أيضاً أنني لا أضع مفتاح البيت في القفل عندما أنام.”. في مارس 1984، وبعد ثلاثة شهور من وفاة بسيسو، أصيب درويش بنوبة قلبية حادة في إحدى فنادق فيينا، وأجريت له أول عملية قلب مفتوح لانقاذ حياته، وقد صادف إجراؤه لعملية القلب المفتوح يوم عيد ميلاده الثالث والأربعين الذي احتفل فيه في المستشفى. بعدها بيومين زاره فجأة الشاعر سميح القاسم وجلس بقرب سريره. كان تلك الزيارة اللقاء الأول بينهما بعد خروج درويش من فلسطين والقطيعة والخصومة بينهما (مغادرة درويش إلى القاهرة 1971، ومعارضة سميح لذلك). تركتُ تلك الزيارة أثراً عميقاً في نفس درويش، وكتب لاحقاً قصيدة بعنوان “أسميك نرجسة حول قلبي – إلى سميح القاسم”، يقول فيها: “إذا ضلّت الروح خارجها. ضلّت روح داخلها. أسميك نرجسة حول قلبي…لنا الذكريات، وللغزو ترجمة الذكريات إلى أسلحة ومستوطنات….أما زلت تؤمن أن القصائد أقوى من الطائرات؟ إذن، كيف لم يستطع إمرؤ القيس فينا مواجهة المذبحة؟ سؤالي غلط لأنّ جروحي صحيحة ونطقي صحيح، وحبري صحيح، وروحي فضيحة…أعانق فيك تفاصيل عمر توقف في لحظةٍ لا تشيخ…سنكتب من غير قافية أو وطن لأنّ الكتابة تثبت أني أحبك، وأنّ لأمي حقاً بقلبك، ويديك يداي، وقلبي قلبك!”. لاحقاً سيتبادل الصديقان الرسائل فيما بينهما ضمن مشروع أدبي نادر وجميل، تكفلت مجلة “اليوم السابع” الصادرة في باريس بنشرها على صفحاتها ولاحقاً صدرت في كتابٍ منفصل يحتوي على الرسائل التسع والثلاثين بينهما.
عام 1986 شهد خروج الفلسطينيين من تونس بعد خلافات بين عرفات وبورقيبة وتفكك منظمة التحرير إلى اليمن والجزائر والسودان، وترافق ذلك مع زيادة في حدة الخلافات الفلسطينية الداخلية. وفي ظل حالة الإحباط هذه اندلعت في ديسمبر 1987 انتفاضة الحجارة الأولى من مخيم جباليا في غزّة. وسرعان ما امتدت الانتفاضة لتشمل كل مدن وبلدات الضفة الغربية وقطاع غزة. بعدها بأسابيع نشر درويش قصيدته الشهيرة “عابرون في كلام عابر”. شرح درويش دوافع كتابته للقصيدة: “كتبتها عندما شاهدتُ على التلفزيون الفرنسي صوراً لجنود إسرائيليين وهم يحطمون عظام الفلسطينيين. كتبتها في جلسة واحدة….أهديت هذا النص ليكون حجراً في يد طفل يرميه في وجه الجندي الإسرائيلي.” نقرأ في القصيدة: “أيّها المارون بين الكلمات العابرة، احملوا أسمائكم، وانصرفوا. واسحبوا ساعاتكم من وقتنا وإنصرفوا!”. أشعلت قصيدة درويش غضب كل الإسرائيليين بكافة تياراتهم من أقصى اليمين حتى أقصى اليسار. وكانت موضوعاً ساخناً في جلسات الكنيست وندد بها رئيس الوزراء الصهيوني إسحق شامير. إجتاحت إسرائيل حمى “هستيريا القصيدة”، حسب وصف درويش، وإتهمته الصحف هناك بأنه “يدعو إلى طرد اليهود من البحر الى نهر الأردن.” تسارعت الأحداث في السنتين الأخيرتين من الثمانينات وخفت وهج الإنتفاضة، ليبدأ بعدها عقد التسعينات بسلسلة أحداث غيّرت موازين القوى عربياً وعالمياً، بدأ من غزو صدام للكويت (إختار درويش الصمت ولم يعبر عن موقف واضح تجاه الغزو)، ثم انهيار الاتحاد السوفيتي وتزامن ذلك مع بدء مفاوضات مدريد ولاحقا اتفاق أوسلو، وما نتج عنه من سلام ناقص، عارضه درويش على مضض.
عام 1996 قرر درويش العودة إلى رام الله، منهياً بذلك حقبة باريس الذهبية، وقضى الاثني عشرة سنة المتبقية من عمره حتى وفاته في 2008 متنقلاً بين عمّان ورام الله وباريس موجهاً كل طاقاته لابداعه الشعري، على الرغم من تعاظم خيباته من مآلات المسار السياسي للقضية الفلسطينية. تباينت الآراء في تقييم شعره ما بعد باريس، فهناك من رأى فيه غموض في المعنى، على الرغم من جماليته الشعرية، وهناك من إعتبره بمثابة القمة في كل ابداعه الشعري. ولكن لن يفيدنا هذا الجدل بأي شئ، إذ “لكلّ منا محمود درويشه”، كما قال صديقه شربل داغر ذات مرة . فزمنه كان زمننا، ونحن عندما نتذكر محمود درويش، فإننا نستحضر ملامح من سيرتنا الذاتية الجماعية، التي كانت قصائد درويش جزءأ هاماً منها. وبهذا المعنى أيضاً، ربما لن نجد أفضل نصيحة لفهم مكانته كمثقف إنساني، من كلمات قالها هو شخصيّاً، حين زار في سنواته الأخيرة مدرسته الثانوية في كفر ياسين وألقى فيها خطاباً هاماً نشره لاحقاً بعنوان “البيت والطريق”: “هل مرّ أربعون عامًا حقًا دون أن أنتبه إلى ما فعل بي الزمن؟، هل كنّا جديرين بأحلامنا الأولى، وأوفياء لأرضنا الأولى؟ أما أنا، فلعلي لا أستطيع الإجابة، ولكني أحيل الأسئلة كلها إلى هويتي الشخصية الوحيدة؛ قصيدتي. أما الزبد فيذهب جفاءً، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض .. وفي الشعر.”