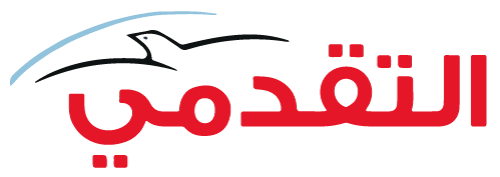في “المقدّمة” يذهب ابن خلدون إلى أن “التاريخ في ظاهره لا يزيد على أخبار عن الدّول والسوابق من القرون الأُوّل، تنمو فيه الأقوال وتضرب فيه الأمثال، إلا أنه في باطنه نظرٌ وتحقيق، وتعليلٌ للكائنات ومبادئها دقيق، وعلم بكيفيات الوقائع وأسبابها عميق، فهو لذلك أصيل، في الحكمة عريق، وجدير بأن يُعدّ في علومها وخليق”. وكأننا بابن خلدون في هذا يحضّنا على التفكّر في الحاجة الدائمة التي لا تنتهي لإعادة تأويل التاريخ، حيث لا قولاً نهائيا فيه، حين تصبح جميع الأحكام خاضعة لإعادة الفحص والتدقيق.
ولعلّ هذا ما عناه الأديب الألماني غوته حين قال إنه “يتعيّن إعادة كتابة التاريخ بين حين وآخر”. وهي دعوة شديدة الجاذبية، ذلك أنها تُحرضّنا على ألا نستسلم للمرويّات المتوارثة، وأن نعيد تدقيقها والبحث عما هو خارجها، بمعنى ما أغفلته سهواً أو عمداً، وخاصةً عمداً، إذا أخذنا بعين الاعتبار الحقيقة المتواترة من أن التاريخ كتبه المنتصرون، فأقصوا، وهم يكتبونه، كل ما لا يتلاءم وأهواءهم ومصالحهم.
لكن عبارة غوته حمَّالة أوجه، فالدعوة لإعادة كتابة التاريخ بين حين وآخر، قد تؤوّل على أنها حثٌ لمن آلت إليهم الأمور لأن يعيدوا كتابة التاريخ وفق أهوائهم ومصالحهم، ما يُقصي مرويّات اعتمدها الناس قبل ذلك، خاصة أنه من المستحيل الجزم بأنّ إعادة كتابة التاريخ هي، في المطلق، أفضل من كتابته الأولى، فهي نفسها قد تكون تزييفاً لوقائع هذا التاريخ، فيما أصحابها يزعمون أنهم يغربلون التاريخ مما لحق به من زيف.
أحدهم قال: “إنّ التاريخ لم يقع .. والمؤرخ لم يكن هناك”. وأيا كان الأمر فإن التاريخ قد وقع، لكن المؤكد أن المؤرخ لم يكن هناك بالفعل، لم يكن موجوداً وقت وقوع الحادثة، وهناك من شبهه برجل المرور الذي أتى متأخراً للتحقيق في حادثة مرورية في مكان وقوعها، وأعدّ روايته لما حدث نقلاً عن الشهود، والشهود ليسوا مجردين من الأهواء، ثم أن محضر التحقيق تضمّن في خلاصته ما ظنّه المحقق صحيحاً، أي ما اقتنع به هو من شهادة هذا الشاهد، لا ذاك. وليس بوسع أحد أن يجزم في صورة مطلقة أنّ هذه الشهادة بالذات هي الحقيقة الناجزة.
في “المقدّمة” أيضاً صنّف ابن خلدون المؤرخين في خانات، أو طبقات حسب تعبيره، ومن هذه الطبقات، طبقة فحول المؤرخين، وذكر منهم: الطبري، ومحمد بن يحيى، ومحمد بن سعد الواقدي، ممن جمعوا أخبار الأمم في كتبهم. ثم طبقة الجهال، ممن وسمهم بالتطفل لأنهم خلطوا الأخبار بالباطل خطأ أو عمداً، واقتفى بعد هؤلاء جماعة قبلوا هذه الآثار واتبعوها وأدوها كما سمعوها، وتليهم طبقة المقلدين، الذين اتبعوا آثار هؤلاء ولم ينقحوا الأخبار ولم يراعوا طبائع العمران فيما حملوه من الروايات، وأخيراً طبقة المختصرين، الذين اكتفوا بأسماء الملوك والأمصار، كما فعل ابن رشيق في “ميزان العمل”.
علينا بعد هذا تخيّل كيف كُتب التاريخ أو أعيدت كتابته. وعودة إلى ما بدأنا به الحديث، فنقول إنّ التاريخ يظلّ دائما بحاجة لإعادة قراءة، وبالتالي لإعادة كتابة، وفي عبارة أخرى لإعادة تأويل. ربما لا يدور الخلاف حول أنّ واقعة تاريخية ما تمّت أو لم تتم، وإنما يدور في درجة أساسية حول الملابسات التي أحاطت بهذه الواقعة، وهو أمر يُذكّرنا بالفارق بين العلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية، ومن ضمن هذه الأخيرة التاريخ، فإذا كان بوسع عالم الفيزياء أو الكيمياء أن يجري الاختبارات العديدة في المختبر للتحقق من النتائج العلمية التي بلغها، فلا تغدو “حقيقة” إلا بعد فحوصات متأنية، فإنّ الباحث في العلوم الاجتماعية يشتغل في فضاءات اجتماعية ومعرفية معقّدة تجعله عرضة للخطأ أكثر من عالم الطبيعة، لأنه لا سبيل سريعاً لاختبار خلاصاته أو التحقق من مدى صحتها. كان الفلاسفة الطبيعيون قد لاحظوا ذلك حين نبهوا إلى أنّ مادة التاريخ بالذات غير ثابتة وغير قابلة للتحديد، لأن الاختبار والتجربة أمران غير ممكنين في الدراسة التاريخية.
ربما تتصل العودة المطلوبة للتاريخ بالجزئيات والتفاصيل التي كثيراً ما جرى إهمالها لصالح التعميمات، أي الوقوف عند الأحداث الكبرى كالحروب والغزوات، وإغفال ما كان خلف ذلك أو في موازاته، بصفتها عناصر لها سياق مستقل له سيرورته الخاصة به التي ظلّت مستمرة ولو على “هامش” التطورات الحاسمة.