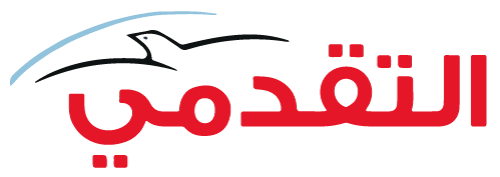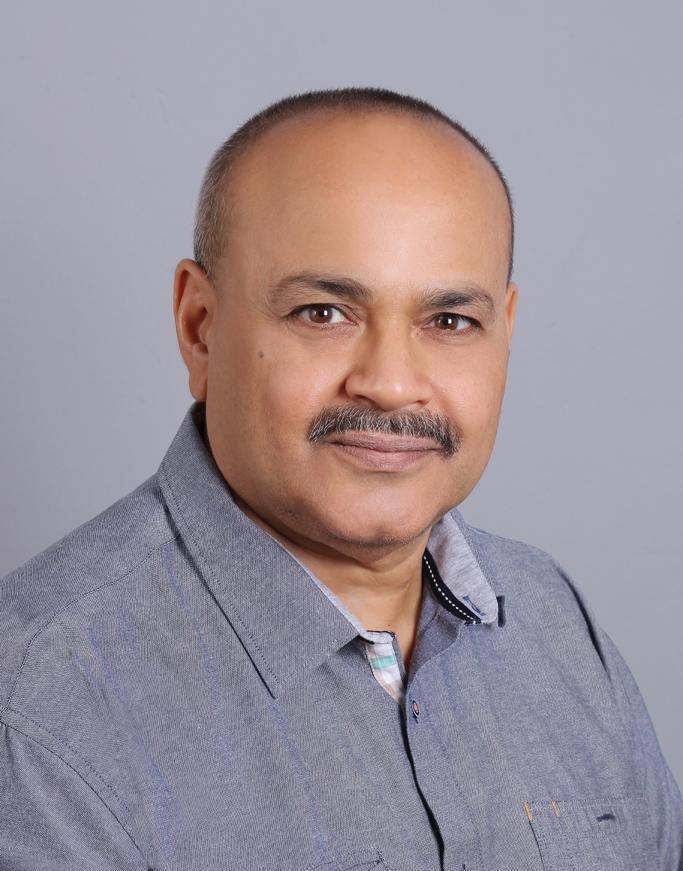كنفاني وفن القصة القصيرة
“بعد كل هذه السنوات يبدو لى أنى عرفت أخيراً من أنـا.. وأين طريقـي ولذلك فأنـا لن أستطيع أن أكتب لك شعراً لأني لست شاعراً، ولا مقالاً لأنى لست كاتب مقال .. ولكى أحافظ على وعدى لك، وهديتى اليك، قررت أن أكتب لك قصة، فمهنتى أن أكتب قصة.”
هذا ما كتبه غسان كنفاني في الحادي والعشرين من يناير 1963، في إهدائه لقصة “القنديل الصغير” إلى لميس نجم، ابنة شقيقته الكبرى فايزة، بمناسبة عيد ميلادها الثامن. كان عمره آنذاك سبعة وعشرون عاما. بعد تسع سنوات من هذا الإهداء، استشهد غسان ومعه لميس، في انفجار عبوة ناسفة زرعها عملاء الموساد في سيارته في بيروت.
جوهر قصة “القنديل الصغير” يكمن في إشكالية تنفيذ وصية أحد الملوك بعد وفاته، والتي تنص على أن ابنته الوحيدة سيحقّ لها أن تحكم من بعده، فقط إن إستطاعت “أن تدخل الشمس إلى القصر”. ولكن كيف ستتمكن الأميرة الصغيرة من تحقيق هذه المهمة المستحيلة؟ . عبر تعرجات حبكة القصة، وتلافيفها المشوقة، سننتهي الى مشهد ختامي: “شاهدت الأميرة منظراً عجيباً، ففي الأُفق المظلم البعيد كان آلافُ الرجال يحملون القناديل ويتقدمون نحو القصر من كافة النواحي.. وبعد قليل وصل الجميع إلى أبواب القصر التي كانت صغيرة ً ومغلقةً، وازدحموا أمامها، وفي كل لحظة كان الرجال حَمَلةُ القناديل يتكاثرون دون أن يستطيعوا الدخول بسبب الأبواب الصغيرة، فطلبت الأميرة من الخدم أن يهدموا الأسوار العالية، وأن يُوسِّعوا الأبواب كي يتيسَّرَ للجميع الدخول إلى باحة القصر”. سيقول لها حكيم القصر العجوز: ” هل تستطيعين أن تحملي كل هذه القناديل دفعةً واحدة” قالت الأميرة: “طبعاً، لا”، فقال الحكيم: “وكذلك الشمس… إنها أكبر من أن يُمسكها رجلٌ واحدٌ أو امرأة واحدةٌ..”، قالت الأميرة: “لقد فهمت كلّ شيء الآن.. إنّ القناديل الصغيرة مجتمعةً هي الشمسُ التي قصدها والدي”.
في “القنديل الصغير” تغلّب غسان على معضلتين: الأولى تكمن في صياغة اشكالية سياسية معقدة (ماهية الحكم العادل الجدير بثقة الشعب) في قالب قصةٍ قصيرة ذات طابع مستمد من الأساطير الشعبية، والثانية هي كيفية سرد تلك الإشكالية وحلّها بلغة بسيطة تفهمها طفلة في الثامنة من عمرها. المثير أنه عندما كتب غسان هذا الإهداء، كان منغمسا في العمل السياسي من رأسه حتى أخمص قدميه (كان كاتب مقالات سياسية بالأساس)، فكيف له، والحال كذلك، أن يقول “مهنتي أن أكتب قصة” ؟. هل واجه تناقضاً، أو تعارضا بين شغفه الأدبي وإلتزامه السياسي؟
عاطفة الكتابة الكاملة لدى كنفاني
ربما نجد التفسير لدى فضل النقيب (أحد أعزّ أصدقائه) حين وصف نشاط كنفاني في بيروت التي وصلها عام 1960، وهو في الرابعة والعشرين من عمره: “في الأعوام الاثني عشر التي قضاها غسان في بيروت، نشر خمس روايات، وكتب ثلاث روايات غير مكتملة تمّ نشرها بعد استشهاده، كما نشر أربع مجموعات للقصة القصيرة، ومسرحيتين، ومجموعة من الدراسات التاريخية – السياسية – الأدبية، ومئات من المقالات السياسية والفكرية والأدبية التي كان يكتبها بشكل يومي، بما أنه محرر القسم الثقافي في مجلة ” الحرية”، ثم رئيس تحرير جريدة “المحرر”، وبعدها رئيس تحرير جريدة “الأنوار”، ثم رئيس تحرير مجلة “الهدف”. ونشر غسان مئات المقالات بأسماء مستعارة مثل فارس فارس وغيرها. وهذا يعني أنه يكتب في اليوم الواحد الأخبار الرئيسية في الجريدة، والافتتاحية في الصفحة الأولى، ومقالا في الفسم الثقافي، كما كان يكتب جزأ من الرواية، وجزءأ من القصة القصيرة، وجزءأ من الدراسة الفكرية.” ويضيف النقيب: “كان مسكونًا بعاطفة الكتابة الكاملة: كتابة القصة وكتابة نقدها، كتابة الخبر السياسي وكتابة التعليق عليه، الكتابة الإبداعية والكتابة الفكرية، الكتابة العلنية والكتابة السرية.”
ويضيف النقيب “الكتابة تصبح عملًا مقاومًا عندما تغيّر من حياة القرّاء، ومن هنا ندرك أن عاطفة الكتابة الكاملة عند غسان كانت تعبيرًا عن الرغبة في التغيير الكامل: التغيير بواسطة الخبر، والتغيير بواسطة المقال، والرواية، وكتابة البحث. “الكتابة الكاملة” عند كنفاني هي “مقاومة كاملة.”
أمر آخر جدير بالانتباه، فالروائي عند غسان يسبق السياسي في فهم الواقع. في إحدى المقابلات مع صحفي سويسري قال كنفاني: “باستطاعتي القول بأن شخصيتي كروائي كانت متطورة أكثر من شخصيتي كسياسي، وليس العكس، وينعكس ذلك في تحليلي للمجتمع وفهمي له… إن قصصي نفسها تفتقر إلى التحليل. ولكن هناك الأسلوب الذي يتصرف به أبطال القصة والقرارات التي يتخذونها والأسباب التي تدفعهم لاتخاذ هذه القرارات وإمكانية بلورة تلك القرارات إلخ.. إني أعبر في رواياتي عن الواقع، كما أفهمه، دون تحليل. . لقد دهشت عندما سمعت حوار أبطالي حول مشاكلهم ( يقصد فيلم “المخدوعون” المقتبس عن روايته “رجال في الشمس”) واستطعت أن أقارن حواراتهم بالمقالات السياسية التي كنت قد كتبتها في الفترة الزمنية ذاتها، فرأيت بأن أبطال القصة كانوا يحللون الأمور بطريقة أعمق وأقرب إلى الصواب من مقالاتي السياسية ” .
المعايير الأربعة لكتابة القصة القصيرة :
منذ بداياته الأولى، تعامل غسان كنفاني مع كتابة القصة القصيرة بوصفها “حرفة”، وكأنها منحوتة يعمل على تشكيلها وصقلها. عملية الكتابة ذاتها ستتحول إلى ورشة عمل ينخرط فيها بحماس وشغف مع من يحبهم. فضل النقيب أشار إلى أن غسان “دوماً يناقش قبل قراءة القصة ليقدّم لها وما هي الفكرة التي يبغي عرضها من خلالها، ثم يناقش بعد قراءة القصة الآراء التي يسمعها، ومن النقاش تتضح الفكرة في رأسه: لقد غيّرته الكتب، ويريد أن يغيّر الآخرين. يريد أن يكتب شيئاً يفعل بالقارئ ما فعلته به “البؤساء” أو “الأم” ولكن بشكل فلسطيني. ويعكف على القلم والورق ساعات طويلة. منذ البداية كان “محترفا” يقضي النهار كله، أو الليل كله مع القلم دون ملل أو ضجر. يأتي للأصدقاء بقصة، وبعد يومين يُغيّرها، ويغيب فترة أسبوع أو إسبوعين ليأتي بدفتر فيه مجموعة قصص جديدة. بعد كل نقاش وشجار يغيّر في القصص، يأخذ موقفاً من واحدة، ويدمجه بواحدة أخرى، يتخلى عن بعض القصص، ويتحدث عن واحدة أو اثنتين، ثم ينسى كل شئ ويبدأ بكتابة قصة جديدة..”. في إحدى المرات أفصح له كنفاني عن التحدي الذي يواجهه باستمرار: “صعوبة القصة إني أريدها واقعية مئة بالمئة، وبنفس الوقت تعطي شعوراً هو غير موجود.” سنعتبر ذلك بمثابة المعيار الأول الذي يضعه غسان لقصصه . المعيار الثاني يكمن في استخدام كلمات بسيطة وغير منمقة للتعبير. يقول غسان: “أنا لا أحبّ كاتب القصة الذي يستعمل كلمة “عسس” بدل “حرس” ، أو “أتزمل” بدل “ألبس”. أما المعيار الثالث فهو الابتعاد عن المغالاة في التعابير، أو ما يطلق عليها غسان علة “اليوسفوهبية” (نسبة الى مسرح يوسف وهبي) ،”حيث يتساقط القتلى بالرصاص والسواطير والسكتة القلبية غير المتوقعة بين كل سطر وسطر.” وأخيرا المعيار الرابع وهو تجنب “استغباء القارئ”، أي أن الكاتب يشرح القصة ومعناها للقارئ.
لخص كنفاني رؤيته بقوله: “من المعروف أن العمل الفني، وعلى وجه الخصوص القصة القصيرة، هو عمل ينجز الكاتب نصفه، ويترك النصف الآخر للقارئ. والبراعة الفنية هي أن يستطيع الكاتب بطريقة غير مباشرة إعطاء القارئ كل المفاتيح التي تستطيع أن تدله على أبواب وطرق ومسالك ذلك النصف غير المكتوب في القصة….فالمفروض أن تكون القصة القصيرة حافزا لخلق عالم خاص داخل رأس القارئ، والقارئ مخلوق عدواني عنيد لا يقبل الوعظ ولا التعليم بالمحقن، وهو يفضل أن يكون موجوداً في العمل الفني على قدم المساواة مع الكاتب، سواء كمعارض أو مكمل أو بطل أو ضحية. أما شخصية المتفرج من وراء لوح زجاج فلا تخلقها إلا أكثر القصص فشلاً. عكس ذلك نسميه: “الإستغباء” ، أي الاعتقاد بأن القارئ رجل تافه لايفهم، وأن على المؤلف أن يدق الفهم في رأسه بالمطرقة!”.
من أطرف ما كتبه كنفاني في فن القصة القصيرة سنجده في مقالة منشورة بتاريخ ١٤/٤/١٩٦٨، بعنوان “فن القصة وميكانيك الأسانسير!” تضمنت نقده لمجموعة قصص بعنوان “النافذة المغلقة” كتبها كاتب اسمه يوسف جاد الحق. غسان طرح مثالاً بالغ الطرافة: “إن كتابة القصة القصيرة عملية مرهقة للغاية تحتاج إلى موهبة قول الشئ بإختصار شديد الإيحاء. إنها من حيث الصعوبة تشبه أن تعمل على كسب موافقة سيدة جميلة، تراها لأول مرة في المصعد، لتقبل منك قبلة عرمرمية قبل أن يصل المصعد اللعين إلى الطابق الخامس، حيث سيتوجب عليها أن تغادرك! ولكن يوسف جاد الحق يضع نصف دزينة من السيدات، جميعهن يردن مغادرة المصعد المذكور في الطابق الأول، وهو بين أن يكبس الزر، ويصلح وضع ربطة عنقه، ويلبس إبتسامته، وينقل بصره بين وجوه النسوان في المصعد، يكون الذي ضرب قد ضرب والذي هرب قد هرب”. ختم غسان مقالته بالقول: “إن يوسف جاد الحق لا يمتلك الصبر، ولا الخطة المسبقة، وهو يستعجل قصته ويتركها تهوي من تلقائها دون هدف ودون نظام ودون هيكل عظمي. ولو أنه يكتب بدل القصص العشر قصة واحدة يضع فيها كل اهتمامه لقرأنا على الأقل قصة من الدرجة الأولى، فهل يفعل؟”.
سعى كنفاني الى الإنصاف وعدم المغالاة في الإطراء، أو النقد. نقرأ له في وصف أحد الكتاب: “إنه صوت جديد ومن الضروري أن يُسمع. قلمه رشيق ويغوص إلى الأعماق ولكنه أحياناً يثرثر كثيراً دون أن يقول شيئاً حقيقياً..ويلجأ للتعقيد وذلك أغلب الظن لغموض في رأسه وليس لغموض في فهمنا.” ويختم تقييمه بتعبير طريف: “إنه سائق جيد، سيارته على أحسن ما يرام، ولكنها “مخنقة”! .