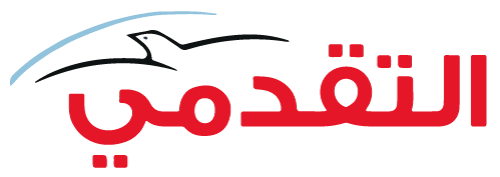تدفع التقاطعات الكثيرة بين الروائية حنين الصايغ وشخصية أمل بو نمر بطلة روايتها “ميثاق النساء” القارئ الفضولي إلى التفتيش عن أدلة تثبت أنهما شخص واحد وأن هذه الرواية ليست سوى سيرة ذاتية لصاحبتها، بل إن الروائية نفسها تضع طُعما لهذا القارئ “الحشري” من خلال نثر قمح الشكوك في طريقه، فالروائية وشخصيتها الرئيسة درزيتان درستا نفس تخصص اللغة الإنجليزية في الجامعة الأمريكية ببيروت، وسافرتا إلى ألمانيا وحتى ديوان بطلة الرواية عنوانه “فليكن” وهو نفس عنوان المجموعة الشعرية التي نشرتها حنين الصايغ. ولكن بعيداً عن هذه الشهوة الخفية للتفتيش عن أسرار الكاتب من خلال عمله، تبقى قيمة النص الفنية هي المقياس بغض النظر عن جنسها الأدبي سواء أكانت رواية أو سيرة ذاتية، وقد توقعت حنين الصايغ ما يثيره هذا التطابق، فصرّحت في إحدى مقابلاتها قائلة: “فضاء الرواية يسمح للقارئ برؤية نفسه والتفاوض معها أثناء القراءة بدلا من التلصص على حياة الكاتب واستخدام النص كوثيقة لاستخراج معلومات عنهم، أقدِّم العمل كسيرة ذاتية، ولكن كرواية”. ويضاعف هذا الفضول أن حنين الصايغ في روايتها الأولى -وهي القادمة إلى الكتابة الروائية من الشعر- تحكي عن طائفة محاطة بالأسرار سكنت الجبال محافظة على عزلتها ألف سنة، فالدعوة إلى تعاليم دينها أُغلقت منذ ذلك التاريخ، بحيث يرفض الدروز الراغبَ في الدخول فيهم كما ينبذون الخارج منهم. كما أنها تروي حكايات نساء الدروز اللواتي بقين إلى ما قبل رواية “ميثاق النساء” البعيدُ لا يعرف عنهن شيئا والقريبُ لا يستطيع أن يقول عنهن شيئا.
لم يكن مفاجئا في نظري أن تنافس هذه الرواية الصادرة عن دار الآداب البيروتية لأجل الفوز بالجائزة العالمية للرواية العربية وقد دخلت قبل أيام قائمتها القصيرة. فعلى امتداد حوالي 400 صفحة تمسك حنين الصايغ بخيوط سردها باحترافية محافظة على لعبة تشويق القارئ ودفعه لطرح الأسئلة ابتداء من العتبة النصية الأولى عنوان الرواية “ميثاق النساء” الذي نعرف من خارج النص أنه عنوان إحدى رسائل “كتاب الحكمة” وهي تعاليم الحكماء الدروز الأوائل لتابعيهم، لكن الروائية تعطيه بعدا آخر تكشفه لنا صراحة بعد أن نقرأ ثلاثة أرباع الرواية فتكتب: “هو ميثاق النساء الحقيقي. ميثاقٌ من التضامن والفهم والوجع لم يخطه أحدٌ في كتاب ولم يفرضه أحدٌ على النساء. ميثاق يجعلنا نتواصل ونترابط على بُعدٍ آخر. بُعدٍ لا علاقة له بالدين والثقافة والجغرافيا. نحن متّصلات شيءٌ ما يتحرَّك في المرأة حين ترى امرأةً أخرى تعاني” في رغبة من الروائية أن تُعامل النساء جميع النساء بالقدسية نفسها التي ينظر بها الدروز ونساؤهن خصوصا إلى نصهم المقدس. وبعد العنوان يثير حيرتنا الإهداء الذي يظهر لنا أول وهلة أن لا علاقة له بالرواية “إلى ابنتي اعذريني لأنني لم أكن أبدا بكاملي معك، أنا أربّيك يا صغيرتي وأربّيني، سامحيني” ولكن هذه الرواية التي تُفتتح بهذا الإهداء من الأم/الروائية لابنتها وتُختتم برسالة من الأم/الشخصية الروائية والرّاوِية في النص، يوسوس لنا من جديد بهذا التطابق بين تفاصيل حياة المرأتين. ولا اعتقد أن الروائية تعنيها كثيرا هذه المقارنات، بل من المفترض ألا تعني القارئ أيضا.
وبعد عتبتَيْ النص والإهداء تأخذنا أمل بو نمر بطلة الرواية في رحلة طويلة معها ترويها بصيغة المتكلم، تبدأها بلحظة مفصلية في حياتها حين نزلت خلسة من قريتها لتتسجل للدراسة في الجامعة الأمريكية ببيروت وهي اللحظة الفارقة التي غيرت حياتها. ومنها تأخذ بيدنا كدليل سياحي لا يرينا الأماكن والمعالم السياحية، بل خبايا التفكير لمجتمع منغلق على نفسه حتى أن جيرانه اللبنانيين من طوائف أخرى يجهلون عنه الكثير. ولا تسير بنا حنين الصايغ على لسان راويتها المتكلمة في خط سير كرونولوجي بل تنتقل زمنيا وحتى مكانيا مستعملة أحيانا طريقة الفلاش باك متوسّلةً عناوين فصول كثّفت فيها أحداث روايتها، فالفصل الأول “الجدار” الذي كان يصلح أن يكون عنوانا ثانيا للرواية، يعطينا مفتاحا بالغ الأهمية للولوج إلى هذا العالم المحفوف بالأسرار، يحكي حادثة تصلح نموذجا دالا على تعقيدات المجتمع الدرزي، فكان لحادثة طلاق مثلا أن تمر عادية تحدث في كل زمان ومكان، ولكن لأن جد بطلة الرواية شيخ درزي فالطلاق يصبح مشكلة كبيرة “لو طلقتَها لن تستطيع أن تردها مرة أخرى، وسيصبح عليك محرّما أن ترى وجهها أو حتى طرف منديلها، وسيكون عليك محرّما أن ترى حذاءها مخلوعا أمام بابها، أو أن تسمع صوتها” كما تنص عليه التعاليم، وما ضاعف المأساة أنّ الشيخ فَصَل نفسه عن طليقته ببناء جدار في غرفتهما حال دون أن يريا بعضهما ثلاثين سنة كاملة إلى أن توفي الشيخ ولم تحضر طليقته مأتمه اتباعا للأصول. وترسم الرواية مشهدا تراجيديًّا لهذا الشيخ الذي كان يطرق على الحائط في الليل يناجي زوجته:”سامحيني يا أمّ علي يلعن الشيطان تسرّعت” فكانت تصمت لأنَّه ممنوع عليه سماع صوتها وتكتفي بالطرق على الحائط ثلاث مرّاتٍ كي يعرف أنَّها تسمعه.
هذا الجدار الرمز والذي كانت عمة البطلة تراه مرارا يتهاوى عليها في نوبات هذيان فتسنده بجسدها، هو ما سعت أمل بو نمر لتحطيم رمزيته، وقد فعلت ذلك مرارا عندما قايضت قبولها الزواج باستكمال تعليمها ففتحت فيه ثغرة ما لبثت أن توسعت، واستكملت تحطيمه حين تركت بيت الزوجية على الثالثة فجرا لتنزل إلى بيروت ثائرة على تاريخ امتد ثلاثة عشر عاما مع زوج ينتهك حرية جسدها متى شاء، ويستبيح جسمها الهش في عمليتيْ تلقيح اصطناعي تركتا آثارها الجسدية وجروحا في الروح لا تندمل. وأمل لا تُدين زوجها في الرواية، بل تدين مجتمعا يفرض شروطه المتعسفة على رجاله ونسائه بل على شيوخه أنفسهم الذين يُحرّم عليهم دينهم “الخروج إلى المطاعم أو المنتزهات العامة، وألا يظهروا بزيهم في الأماكن العامة إلا عند الضرورة”. فكان لا بد لهذه الظروف غير الطبيعية أن تشكل في نفسية أمل الهشة عدة عقد ليس أقلها التقليل من قيمتها ولوم نفسها وسقوطها في دوامة الاكتئاب الذي وصفته بقولها “الألم هذا الشعور الدائم الذي يتملكني وكأنَّني في مأزقٍ أو في كابوس لا ينتهي وكأنَّ حياتي فخّ أستيقظ منه كلَّ صباح حتى أسقط فيه مجدّدًا”. ولم يخلّصها منه سوى شيئان: ما فتحه لها تعلمها من آفاق في استكمال الدراسة في بيئة منفتحة مثل الجامعة الأمريكية في بيروت ومن ثَمَّ فرصة العمل في رحابها، والحبُّ الذي سرقها من واقعها مع توأم روحها وعقلها وإن كان من غير دينها وبلدها. هذا الحب الذي كتبت عنه حنين الصايغ أو أمل بو نمر لا فرق بفلسفة ترتقي إلى مقامات العشق الصوفي حين تقول مثلا “من الصعب أن نسأل العاشق عمَّا يحبّ في معشوقه. وإن أجاب هذا العاشق بصفةٍ أو ميزةٍ في حبيبه فلا يكون يحبّ هذا الحبيب، بل فقط يحبّ تلك الميزة فيه” وهذه اللغة الشاعرية في الحديث عن الحب نجد لها مثيلات في الرواية، فقد تسربت مقاطع كثيرة هي أقرب إلى الشعر لم تستطع حنين الصايغ أو لم تُرِدْ منعها من التجلي على صفحات روايتها كحديثها عن السفر “المطارات لا تعبأ بدموع المودعين ولا بزهور المستقبلين. كان السفر بالنسبة إليّ موتًا صغيرًا أو نفقا بين قبرين كان الطيران مجرَّد هدنةٍ قصيرةٍ مع هذه الأرض التي تتكئ على وجودي بكل ما أوتيت من قسوة.. قبلك كانت كلّ الغايات متاهاتٍ أختبئ فيها من اللا غاية”.
يبقى أمران يجدر ذكرهما أولهما: أن الرواية ليست إدانة للمجتمع الدرزي بقدر ما هي إعادة رسم صورة واقعية له تبعده عن الأسطرة وتخرجه من دائرة التكهنات، فتعرض مشاكله التي نجد مثيلا لها في كل مجتمع منغلق على نفسه للحفاظ على خصوصيته، وقبل ذلك للحفاظ على وجوده. وثانيهما أن الرواية أبعد ما تكون عن النسوية ببعدها الإيديولوجي، فليس فيها محاكمة للرجال وإدانة للبطركية والسلطة الذكورية فالرجال والنساء على السواء ضحية تشدّد فرضته ظروف تاريخية، بل نجد في الرواية نماذج ذكورية جيدة مثل الأستاذ خلدون قتيل الحب الذي يدعم تلميذته، أو “جاد” صهر أمل الذي أحب زوجته إلى درجة موافقته على إجهاضها وطلبها الطلاق، أو حامد الكاتب الذي كان طوق نجاة لأمل عوّضها عن حياة القهر.
“ميثاق النساء” رواية تحتفي بالحب والأمومة والحرية، استعملتْ فيها حنين الصائغ مبضع الجراح لتشريح انعكاس الانغلاق على النفوس الهشة وحيث المرأة كما هي دائما الضحية الأولى له، ولكنها أبقت باب الأمل مفتوحا يظهر فيما قدمته أمل بو نمر من نصيحة غالية لابنتها رحمة: “سأهبكِ هذا الخيط، وسأذكرك دائمًا أنَّ في الجانب الآخر منه في الجانب البعيد، سيكون قلبكِ، وأنَّ في قلبكِ ستجدين الله والحبّ والحقيقة”.