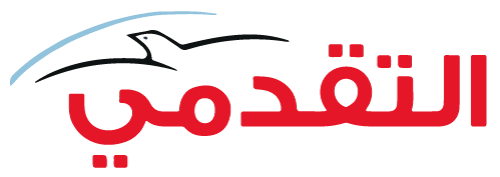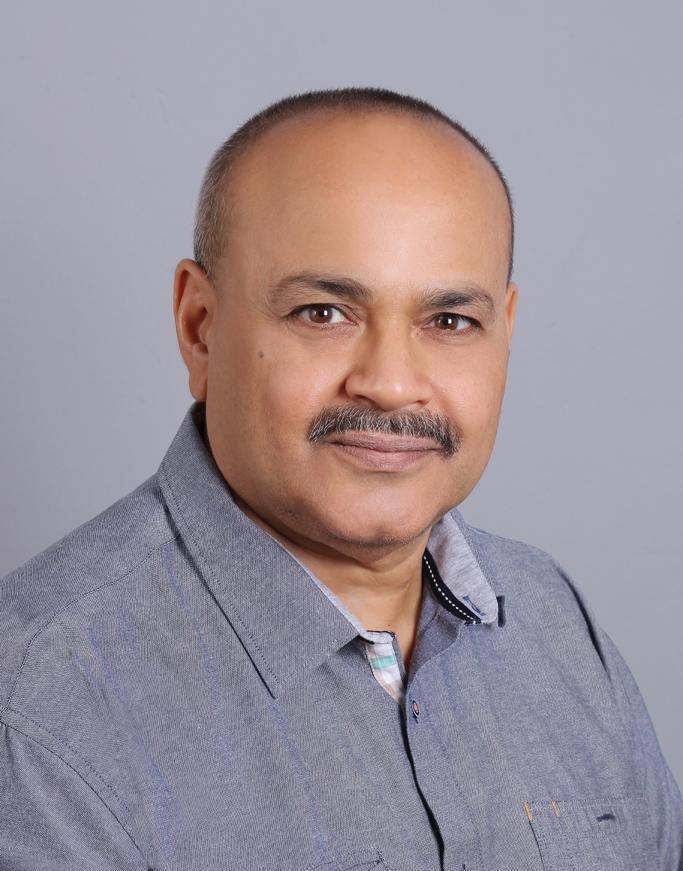ما الذي يدفع كاتباً مشهوراً، ينشط في بلد تتوفر فيه حرية التعبير (لبنان)، إلى الاستعانة بأسماء مستعارة مختلفة، ويكتب عبرها مقالات نقدية ساخرة ينشرها في مجلات وصحف مرموقة؟ . هذا هو السؤال الذي قد يتبادر إلى ذهن القارئ وهو يهمّ بتصفح كتاب غسان كنفاني “فارس الفارس” الصادر لأول مرة عام 1996 في طبعته الأولى عن دار الآداب البيروتية (صدرت نسخة عام 2024 في عمّان عن دار الفينيق للنشر). يحتوي الكتاب على أكثر من سبعين مقالة نشرها كنفاني تحت إسم “فارس الفارس” في ملحق “الأنوار الأسبوعي” خلال عام 1968، وأخرى نشرها في مجلة “الصياد” عام 1972 حتى استشهاده في ذلك العام. الإسم المستعار بوصفه واحة حرية: لم يلجأ كنفاني للإسم المستعار خوفاً من القمع والبطش، كما هو شائع لدى الآلاف من الكتّاب الذي ينشطون في ظل أنظمة استبدادية وقيود الرقابة المكبلة لحرية التعبير. ما سعى إليه كنفاني هو الكتابة ضمن مساحة إضافية ولكنها ضرورية للتخفف من الحرج الاجتماعي الذي يتلبس عادة الكثير من الكتّاب/النقاد حين يسعون لطرح وجهة نظرهم الصريحة حيال ما يقرأونه من إصدارات، إذ يعلمون تماماً مدى الحساسية المفرطة التي يشعر بها الأدباء والكتّاب والفنانون على مختلف مشاربهم وتوجهاتهم الفكرية والسياسية تجاه أيّ نقد صريح لأعمالهم، خاصة إذا أتى هذا النقد من أصدقائهم وزملائهم. وكما يقول محمد دكروب: “بنى غسان كنفاني لنفسه واحة يفئ إليها…يشعر فيها – ربما – بأنه أكثر حرية وتفلتاً وانفلاتاً مما هو في مجالاته الإبداعية الأخرى.. كان غسان يأنس إلى هذه الواحة مرة في الأسبوع.. وكانت تلك المقالات الأسبوعية طرازاً فريداً في النقد الأدبي العربي يتناول فيه الأعمال الأدبية والفنية بسخرية ضاحكة”. من جانب اخر كتب كنفاني تلك المقالات الأسبوعية ليفلت قليلا من “وطأة المستلزمات النضالية وموجات الحزن في ذلك الزمان، زمن الوطء الثقيل الموجع المفجع لهزيمة حزيران 1967.” حسب تعبير دكروب، ويضيف أن واحة كنفاني تلك كانت “واحة ضاحكة باسمة ساخرة وسط عبوس الثقافة العربية، الحزبية والجادة جدا في ذلك الزمان” . لا عجب إن تمّ اعتبار كنفاني من قبل العديد من الكتاب بأنه كان رائد الصحافة اليسارية غير المملة بلا منازع. لم يسلم كنفاني من الهجوم عليه حتى حين لجأ للأسماء المستعارة.”منذ إخترت أن أكتب هذه الزاوية كسبت من الشتائم ما لم أحلم بكسبه في حياتي مضروبة ثلاثة !”، كما يقول في إحدى مقالاته في مايو 1968. ويضيف قائلا : “البعض يقول إن فارس الفارس شخص غير حقيقي، والبعض يقول إن إسمي مستعار (لمجرد أنهم لم يتعرفوا إليّ شخصيا) والبعض يقول إن أحدهم يكتب لي، وهذه الاتهامات تتبع تكتيكاً متعفناً هو محاولة إشغالنا بمعارك جانبية عن الالتفات إلى حقيقة الموقف النقدي.” ويشير كنفاني إلى الشتائم التي طالته وطالت أيضاً كتّاب ومدراء تحرير “الأنوار” و”الصيّاد”. السخرية أكثر معنى من النكتة من جملة المواضيع العديدة في الكتاب، لفت نظرنا على وجه الخصوص كيف لخّص كنفاني رؤيته لفن السخرية في ثلاث مقالات هامة ( بين المهضوم والغليظ ميزان إسمه جحا! “/ معجم سالم ..لانتخابات مكسرة/ عن كتاب مزعج). في تلك المقالات انتقد كنفاني الكتابات التي لا ترتقي بفن السخرية بل تقوم عوضاً عن ذلك بتطوير لفن التهريج. ويشير إلى أن الإطلاع الأدبي، والموهبة النقدية، والوعي السياسي، هي ثلاثة عناصر تساعد على الإرتقاء بفن السخرية العربي من تخوم التهريج إلى مستوى النقد السياسي والإجتماعي والفلسفي. قرأ كنفاني التراث العربي بعينٍ فاحصة ونقدية، وتوّصل إلى نتيجة أن “الأدب العربي كان فقيراً في فن السخرية فقره في علماء الذرة. ومع أن أسماء مثل الجاحظ، وبديع الزمان الهمذاني، وجحا، والمازني كانت جديرة بإرساء قواعد أدب عربي ساخر من طراز عالمي، إلا أنه يبدو أن الجيل المعاصر قد ولد مُكشراً” حسب تعبيره. يفرق كنفاني بين تنكيت “أبو نواس” وعبقرية السخرية لدى جحا. يقول: “إن فن السخرية هو أصعب فنون الكتابة على الإطلاق، إذ المطلوب من الكاتب أن يقنع القارئ بأن دمه خفيف …ومن هنا بالذات تكمن الصعوبة في السخرية، فهي شئ أعمق من “الاستلباس”، وأكثر معنى من النكتة”، ويشير إلى أن “الأدب الساخر ليس تسلية، وليس قتلاً للوقت، ولكنه درجة عالية في النقد.”يُميّز كنفاني بين نوعين من السخرية: “السخرية الهدّامة سهلة بالمقارنة مع السخرية البناءة، فالأخيرة تحتاج إلى وعي أعمق وثقافة أوسع ومقدرة أكبر على فهم روح القارئ.” ثم يطرح كنفاني التحدي الذي يواجه الساخر: ” كيف يمكن للسخرية أن تكون بناءة وتظلّ في الوقت ذاته أدباً ساخراً خفيف الدم، لا محاضرات فيه ولا أوامر ولا استغراق مزيف في الأيدولوجيات؟ هذا في الواقع أمرّ يخص المؤلف ذاته. وهو المطالب بايجاد وسيلة ومخرج.” في مقالةٍ مهمة بعنوان “عن كتاب مزعج” إنتقد فيها كنفاني بحدّة أحد الكتاب – إسمه سالم الجسر – الذي ألّف كتابا أسماه “المزعجون” يتضمن سخرية جارحة لنماذج من الثقلاء الذي تزخر بهم الحياة. يقول كنفاني: “إن السخرية ليست تنكيتاً ساذجاً على مظاهر الأشياء، ولكنها تشبه نوعاً خاصاً من التحليل العميق. إن الفارق بين النكتجي وبين الكاتب الساخر يشبه الفارق بين الحنطور والطائرة، وإذا لم يكن للكاتب الساخر نظرية فكرية فإنه يضحي مهرجاً…إن السخرية ليست في إيراد التعبيرات المضحكة ولكن في الأسلوب الذي يشعر المرء، من الأول إلى النهاية، بكرباج الإبتسامة الجارحة يعمل في الموضوع نقداً عميقاً، وكي يستطيع الكاتب أن ينقد بسخرية فإنه أولاً يجب أن يمتلك تصوراً لما هو أفضل”، ويواصل كنفاني قوله “إن السخرية تعطي، عن طريق الضحك، نقداً يلخص المشكلة بأفضل من مليون مقال.” ثم يضرب كنفاني مثلاً من أجمل وأعمق الأمثلة على فن السخرية الهادف بقوله: “خذ مثلاً على ذلك ما يردده رجل إنجليزي: المعروف أن كلمة “بييس “Peace بالانجليزية تعني السلام، وأن كلمة Piece التي تلفظ بنفس الطريقة تعني قطعة، قال إن “البيس” التي يريده الاسرائيليون هو “بييس” من مصر و”بييس” من الأردن و”بييس ” من سوريا! … هذه السخرية ليست ضحكة فقط، ولكنها اكتشاف يلخص جوهر الموضوع كله، وانتقاد يغني عن ألف مقال. لأنه يضع قضية “السلام الإسرائيلي” كلها في عشر كلمات موجزة، ويستطيع أي كان، وهو يضحك عليها أن يتعلم منها أيضا.” ويقول كنفاني: “أريد أن أقول إن الجملة الساخرة الأفضل هي الجملة التي يبذل فيها جهد أكثر. فالسخرية ليست مثل المنشور الحزبي لأنه حيثيات وشروح وشعارات وملئ بالكلام الذي قيل سابقا، ولكنه من النوع المختصر الذي ينفجر مثل القنبلة، فيهزّ القارئ ويفاجئه ويحرك في رأسه الراكد عشرات من الصور والتخيلات.” جانب آخر من سياط سخرية كنفاني تمّ تسلطيها على موجة الأغاني المبتذلة التي راجت في تلك السنين. نقرأ في مقالة بعنوان: “إنقاذاً لكرامتنا الفنية المهدورة، مطلوب ماوتسيقار فوراً!!”، ما يلي: “لماذا يتوجب على حياتنا الفنية أن تكون مملكة للتافهين والعاطلين، يرجموننا بكل ما يقع تحت أيديهم بقلّة ذوق لا مثيل لها، ثم يكونون – هم ذاتهم – وجهنا الفني وحضارتنا؟”، ويضيف قائلا: “إن أبشع بياعة العربات فيها منطق ومعنى ولمسات شعرية أكثر من 99 بالمئة من أغانينا”. كان كنفاني يقصد في مقالته موجة الأغاني على غرار أغنية “عالبطاطا البطاطا” وغيرها التي لقت رواجاً تلك الأيام، وأطلق على تلك الموجة من الأغاني تعبير “هزيمة 5 حزيران الفنية” (على وزن نكسة 5 يونيو 1967). يطرح كنفاني سؤاله: “من المسؤول عن ذلك؟ ..ليس هذا مستوى مؤلفي الأغاني في البلد، ولكنه من المؤكد أنه مستوى المحظوظين والزلم وأبناء العادة (العادة، في هذا البلد، لها أولاد، فإذا اعتاد مسؤول على اسم فإنه يلتصق به ولا يستغني عنه ويقبله جملة وتفصيلاً). في نفس المقالة يوجه كنفاني نقده لظاهرة “تبشيع الأصوات في البرامج الفكاهية” ويقول “ليس في تشويه اللهجة أية طرافة! أهذه هي حاستنا الضاحكة في هذا البلد؟ إنها شتيمة لنا!.” تحضر في أذهاننا ملاحظات كنفاني أعلاه ونحن نشاهد ونقرأ انتشار “التهريج” و”التنكيت” في المسلسلات المنتشرة في الفضائيات والمنصات الرقمية وووسائل التواصل الاجتماعي. لقد إعتاد الرأي العام على التهريج إلى درجة فقدان القدرة على التمييز بينه والسخرية الهادفة بالمفهوم الكنفاني.”فارس الفارس” أحد المؤلفات العابرة للزمان والمكان بحق، إذ تتجلى في أسلوب مقالاته ما يذكرنا بسمات الكتابة الإبداعية وفق ما حددها ذات مرة الكاتب الايطالي “ايتالو كالفينو” وهي: الخفة، السرعة، الدقة، الوضوح، التعددية (لاحقاً أضاف صفة الإتساق). المقصود بالخفة هو الأسلوب الذي يصوغ فيه الكاتب أفكاره عبر الابتعاد عن كلّ ما يثقل بُنية النص الذي يكتبه. أما السرعة فتعني الإنسيابية في النصّ التي تجعل قراءته مريحة (وحسب تعبير إستخدمه الناقد والروائي الكويتي طالب الرفاعي: إسرع بتمهل). وتشير الدقة في بعض جوانبها إلى استخدام لغة محددة بعيدة عن التصنع، مع استحضار صور بصرية حادة في التعابير تعلق بذاكرة القارئ، وتساهم في وضوح ما يقصده الكاتب، أما التعددية لدى كالفينو فهي حين يساهم النص الإبداعي في فهم أفضل لشبكة الصلات بين الأحداث والناس وكيفية تفاعلهم معاً.