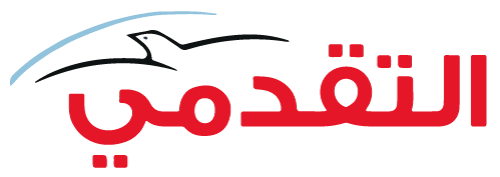ماذا تسمون من يكون سعيداً يوم الأحد؟ متقاعد!تُنسب هذه المقولة الطريفة إلى مجهول حَطَّ فكرته ومضى، لكنه عَكَس شعور التخلص من روتين العمل الذي يستمر لثلثي عمر الإنسان، ثم يختار بعدها حالته في أول الأسبوع؛ هل سيجد حياة جديدة ومختلفة بعد التقاعد، باعتبارها منحة جديدة يمارس فيها كل ما فاته في وقته السابق بحكم ارتباطاته الوظيفية؟ أم سيكون رهين التعلُّق بالماضي وزهرة الشباب “المزعومة” التي ذهبت في سبيل من لا يقدِّرها، مع كثير من البكائيات والنواح غير المجدي؟ ذلك أن التقاعد هو شعور التخلي والخذلان، وأنه محارب ومضطهد وزائد عن الحاجة، وكلها أحاسيس تجعله وحيداً، قابلاً للموت! ورغم كونها فكرة تميل للفنتازيا، لكنها واقعية وملموسة للأسف، وبخاصة للأشخاص من مدمني العمل وتروسه.يصف نص “الفانوس”، لمؤلفه الكاتب الإماراتي محمد سعيد الظنحاني، الحالة الداخلية لبطله الذي تم التخلي عنه في غفلة من الزمن. هو الذي كان يركن قوته بانتسابه للوظيفة محور حياته؛ حيث لا حياة له بعدها، أتى على ذِكرها في معظم مقاطع النص الأربعة والعشرين، والمكتوبة بما يتناسب وتقسيم شعوره بين فقْد الوظيفة؛ الموازي لفقد كل معاني الوجود، وانحسار الأضواء الذي أشعره بالظلام، فبات يلاحق أي شعاع من بعيد؛ ومعاناته ووصفه لتكوينه الأسري وعلاقته بوالدته -تحديداً- والذي يعني تباعاً تكوينه النفسي المكتشف مقطعاً بعد الآخر؛ وعلاقته الرمزية بالفانوس الذي استحوذ على النص وفكرة العرض.يحسب للمخرج خالد أمين الاشتغال على النص مجدداً، وقراءته المغايرة في “الفانوس”، رؤيةً مختلفةً تماماً، استنبطها من فكرة النص وبعض الملامح التي عمل على تطويرها؛ حيث ذهب النص إلى جعل الفانوس أحد أفراد العائلة: “كنا أربعة: أنا وأمي وأبي والفانوس. ذهبوا ولم يبقَ إلا أنا.. أنا وأنت. متى أردت التخلي عني، لحقت بك.. أنا وأنت توأمان؛ ما يصيب أحدهما يصيب الآخر”. وهذا التعلق الذي أصاب البطل بفانوسه ليس وليد وحدة أو مشاعر متعلقة بأن الفانوس عاصر والديه، بل هو بمثابة وصية عُهدت له من والده بمعاملته كــ”أخ”! برمزية تحمل في داخلها الكثير. وعوضاً عن أن يكون الفانوس فانوساً مادياً في يد البطل، ارتأى المخرج أن يحدث الفارق بدمية فانوس -على اسم البطل داخل العرض-، حتى تولد بذلك الملازمة بين الطرفين في كل التفاصيل. والفانوس الذي آثر المخرج ألا يغير عنوانه عن النص الأصلي، يعني النور الذي يطرد العتمة. وهذا الالتصاق بين البطل وفانوسه كأخٍ ونِد في النص والعرض، يتزامن في أوقات التوهج والتألق، وحتى الانطفاء، في ترابط عنى به فترات حياة البطل. الفانوس هنا، وأشكال أخرى من الفوانيس كما أشار إليها المخرج في جزء من كلمته في كتيب العرض: “لكل مخلوق في الحياة فانوسه الخاص لينير له دربه. أما فانوسنا، لا ضوء له. فانوسنا روح؛ روح تعبة، انهارت بعد الفقد، وأكملت انهيارها إلى أن أصبحت جوفاء فارغة، والفراغ حكمها حتى أصبحت ظلمة”. وهكذا حتى أصبح بطل العرض مجهول الاسم هو نفسه فانوساً، دقة بدقة. ويلاحظ هذا في شكل الكتيب الذي عهد بتصميمه للفنان نصار النصار، الذي استوعب الحالة الشعورية والتوأمة لدرجة الالتصاق بين الممثل والدمية، وارتباط حياتهما ومصائرهما معاً، فأظهر التعبيرات المتطابقة كما يجب.ويقوم عرض المونودراما بخداع المخرجين المبتدئين والمتحمِّسين، والذين يعوِّلون على وجود شخصية واحدة ومونولج طويل يسرد بطريقة أو بأخرى؛ متغافلين بذلك عن ارتهان هذا النوع من العروض لأداء الممثل وقدرته على تحمل عبء توظيف كل العناصر المسرحية المساعدة، والقدرة على إيصال الحالة من خلال الأدوات المتاحة؛ بصرية أو سمعية أو مادية. اختار المخرجُ أمين الممثلَ عبدالله التركماني، صاحب الحضور المميز والموهبة التي تتقولب أينما يوضع، في تقمص شديد للشخصية؛ تقمص صادق مشحون بروح فانوس المخذول، الضئيل، الواشك على الانطفاء، ولولا بعض العبارات المحلية التي قطع بها لغته العربية لنسي -ربما- الجمهور أنه الممثل الذي يسرق النظر في الكوميديا والتراجيديا على حد سواء.استطاع التركماني الاتصال بجمهور الصالة الذي توحد مع معاناة المتقاعد، وتوحد معه رغماً عنه، بفضل هذا الأداء الواعي للممثل في قراءة الشخصية وما يحولها. فالبطل في النص عانى من علة غير واضحة، أودت به لحرمانه من الزواج والإنجاب، وهو ما كان يرغب به ويردد ما يردده الآخرون الذين يربطون وجودهم في الحياة بوجود ذرية تضمن الوجود -الاسمي- لهم في الحياة، دون إقران هذا الوجود بالأثر ومعنى الوجود. وطالما لم يرد هذا المفهوم على فانوس؛ الذي يفصح بمباشرة: “إن ذلك العجوز، أبي، استطاع أن يحقق ما لم أستطع أن أحققه بعده. فأنا اليوم أختفي وأخفيه!”. لذلك زادت أسباب الفقد لديه وتكاثرت: الأم أولاً، والعائلة التي يرغب تالياً، وأخيراً العمل الذي أجهز على الباقي من أسباب الاستمرارية والعيش، فانتهت الحياة.وجرت العادة؛ استخدام الدمى في المسرح في أعمال مسرح الطفل أو المسرح المدرسي، لتقريب الصورة والمعنى للفئة المعنية من الجمهور؛ حيث الحرص على جذبهم واستقطابهم، لكن هذه الصورة الذهنية قد تغيرت قليلاً حينما استعان مسرح الكبار بهذه الأداة، خصوصاً في عروض المونودراما؛ حيث إدماج الدمى حيلة ذكية لخلق علاقات مع الشخصيات الأخرى، واستعانة البطل/ة بأدوات تعبر فيها عن الحالة، لكن وجود الدمية يساهم بشكل كبير في إيصال شعور الوجود البشري لممثلين آخرين، خصوصاً إذا كان العمل منضبطاً ومتقناً، كما تفعل فنانة الدمى المتخصصة د.خلود الرشيدي التي تحرص على ديناميكية الدمية لتسهيل تفاعلها مع الممثل، وقامت بهذا مسبقاً في عدد من العروض المهمة، مثل العرض المونودرامي غلطان بالنمرة/ الذين على يمين الملك/ كيري ميري/ الهجين/ لنشرب القهوة/ الزمر.وصنع العرض هنا الدمية الأساسية لفانوس، والأم والمدير في العمل الذي استوحى المخرج شخصيته “اللينة” من حديث النفس للبطل عن روحه المخطوفة بعد خروجه من مكانه لفخ العمل، والتمدن، والإيقاع السريع: “سرقت المدينة الكبيرة هناءة عيشنا، وفتحت أبواب الفراغ. نلجها إلى غرف يشيدها رجال أو أشباه رجال.. بلا قلوب ولا رحمة”. وقامت الرشيدي بتنفيذ الفكرة شكلياً على دمية المدير ذي الشعر الناعم، مع أداء دالٍّ جداً من الممثل على طبيعة الشخصية. وبالإضافة إلى استخدام العرض للدمى الثلاث الرئيسية، وُجدت عرائس أخرى معلقة ضمن الديكور.وعلى صعيد متصل، تبرز الأزياء التي صممتها الدكتورة ابتسام الحمادي في اتّساق مع حالة الفانوس المتأرجحة، القلقة في المنطقة الرمادية من كل شيء، فاختارت المصممة أن تلبس بطل العرض اللون الرمادي الدالّ على المنطقة الحائرة التي تعيش حالاتها علناً أمام الجمهور، وهذا ينطبق على الدمى المرافقة؛ حيث دمية فانوس التي تلبس نفس زيه تماماً، إشارة إلى تلاحم الشخصيتين، وحيث دميتا الأم غير محدد الهوية، وهذا شكل إيجابي يصبّ في عدم تعيين بيئة العرض بإشارة دالة، والمدير في العمل التي تمت الإشارة إليها سابقاً.ولم يتجاوز عرض “الفانوس” مدة نصف ساعة إلا بقليل، وتلك ميزة أخرى لا ينتبه لها المخرجون الذين يتولون “تنفيذ العرض” دون الدخول في مضمونه، مما يسبب تشتت الجمهور بشكل كبير، خصوصاً إذا ما تزامن هذا مع إيقاع غير محسوب، وفي عروض المونودراما تحديداً. ورغم هذا؛ كانت هناك مسألتان تستحقان النظر فيهما لو قُدِّر لهذا العرض أن يُعاد: أولها إعادة النظر في ديكور ملأ الخشبة حتى أزحمها بدون استعمال حقيقي، أو ارتباط بفكرة العرض، بينما لو استخدم كرسياً وحيداً أسود يُستخرج وقت الحاجة، سواء للمدير أو للأم باعتبار أنهما لا يظهران في مشهد واحد معاً، كان سيبدو مريحاً للعين أكثر، خصوصاً أن البطل يعبر عن فكرة الخواء النفسي حينما يعبر: “كل شيء حولي فراغ.. كأني بين كفي فراغ”؛ وأيضاً لا يمكن إغفال التشكيل السينوغرافي الرائع الذي ختم به العرض في سرير يتوسده فانوس وتوأمه ليكون هذا وداعه/ وداعهما وانطفاءهما الأخير. ويتعلق الأمر الآخر بالإضاءة التي رمت في النص الأصلي إلى انحسار الأضواء عن الشخصية، وصارت تلاحق أي بصيص ضوء تكون تحته، بينما لم يستغل العرض هذه الفكرة التي تؤرق جميع من شعروا/ يشعرون بسحب البساط من تحتهم -وهم بيننا- فباتوا يفعلون أي شيء من أجل هذا البقاء المرهون بالتواجد، ولو بالزيف. فهل تستحق الأضواء، أو الوظيفة، كل هذا الاضطراب الجلل؟جزء كبير من نجاح هذا العرض وتفاعل الجمهور معه، بالرغم من أنه خارج المسابقة الرسمية المقامة في مهرجان الفجيرة للمونودراما في نسخته هذا العام: حُسن اختيار المخرج خالد أمين لطاقم عرضه المميز بانشغالاته الفردية، والنجاحات الملموسة، والعاملين بروح الفنان الحر الذي صقلته الدراسة والخبرة ومن قبلهما الموهبة، بالإضافة إلى الأساس، عبر الأخذ بخلاصة فكرة الفانوس ومعالجتها، حتى وإن تعاطف المتلقي مع معاناة متقاعد يرى في حفلة وداع العمل بمثابة كتابة شهادة وفاة. لذا كانت رسالة أمين في هذا العرض واضحة؛ لكي يختار كل منا فانوسه الخاص قبل أن يحين الوقت.