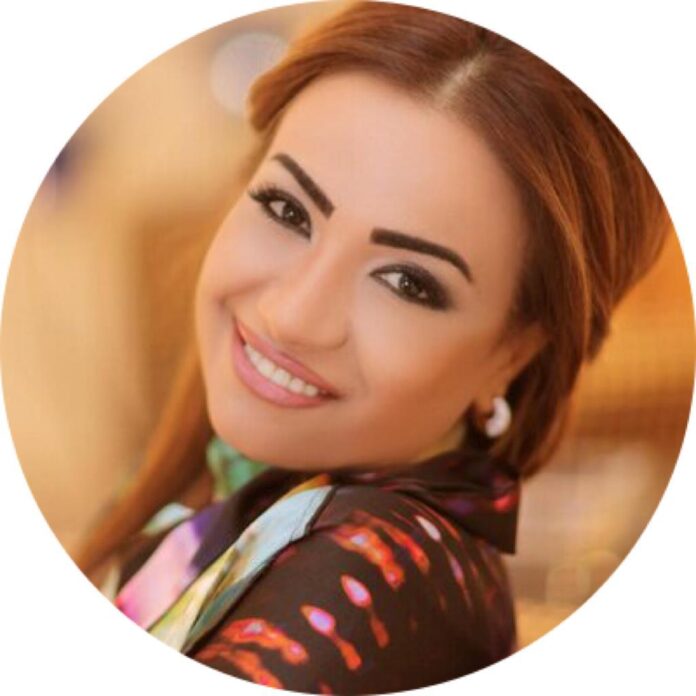لعبت العاطفة دور بوصلة يسترشد بها الكتاب والمبدعون لبلوغ الأماكن الخفيّة التي تختبئ فيها تخيلاتهم والهامهم وذخيرتهم الابداعية. وهذا الأمر يحدّده أصحاب الاختصاص في علم النفس على أنه من محرضات العبقرية كونها مرتبطة مباشرة بالعاطفة حتى وإن كانت متوفرة جينيا في الشخص.
أمّا تتبع موضوع كهذا في عالمنا العربي فيبدو صعبا جدا، حتى حين تشجع بعض الكتاب ونشروا رسائلهم كأزواج بينهم، بقى الخجل من البوح بكل ما حملته تلك الرسائل عائقا لمعرفة أجيجها الحقيقي ومدى تأثيرها لتوهج عبقريتهم الأدبية.
سنوياً تصدر في العالم الغربي كتب تكشف مزيداً من الجوانب الخفيّة عن علاقات الحب التي عاشها أشهر أدبائه، إذ لا يزال سارتر وسيمون دي بوفوار يسيلان حبرا كثيراً بسبب علاقتهما الفريدة من نوعها، رامبو وفيرلين، وغرابة الحب في حياة مارغريت دوراس، وآخرون.
تعجبنا هذه الموضوعات في جلسات خاصّة، وكل جيل لديه قصصه التي تندرج ضمن “النميمة” بين الأدباء. من النادر أن نجدها تسللت إلى المكتوب وظهرت إلى العلن. ونحن نشعر إذ ذاك أن موضوع الحب يستملحه الكُتّاب العرب كمعطًى افتراضي، يخاطبون فيه كائنات غير موجودة أو هذا ما يسعون إلى إقناعنا به.
في رواية التونسية أميرة غنيم “نازلة دار الأكابر” نكتشف أن واقعة الحب نازلة في حدّ ذاتها، أي مصيبة من كبائر المصائب في المجتمع العربي، حيث استحضرت أجزاء من حياة سابق زمانه المفكّر الطاهر الحدّاد، ورسمت وفق مراجعها حول الحقبة التي عاش فيها المصاعب التي عاكست حياته وقصّرت من عمره، وشكّلت عقدة محنته هو الذي ولد وكبر في مجتمعه وكأنّه زائر من زمن المستقبل.
بعد ست وثمانين سنة من وفاته ترى هل تغيرت نظرة مجتمعنا للحب وهل تجرّأ الكتاب والشعراء بالبوح بما تخفيه خلفيات “نصوصهم” العاشقة؟
في مفهوم لقاسم أمين “الحب هو وتر الشّاعر وريشة الفنّان، وتغريدة الطّائر، وتفتُّح الزهرة، واشراقة الصباح” وهو أيضا أي الحب “أعلى قمّة في جبل الحكمة”، وقد توفي هذا المفكر المصري الرائد هو الآخر في الدفاع عن حقوق النّساء شابا في الخامسة والأربعين العام 1908. وبعد قرن وبضع سنوات من وفاته لا يزال مفهوم الحب نظرياً هو نفسه، لكنه يختلف في الغالب حسب النسق الاجتماعي الذي ينمو فيه بين طبقة أمين وطبقة الحداد، بين المجتمع المخملي الأرستقراطي في القاهرة وبين نفس المجتمع في تونس. شتّان بين الإثنين، أو هذا ما يرويه لنا الأدب والتاريخ على الأقل.
في رواية غنيم نكاد نرى الغالبية الساحقة من مجتمعنا اليوم، وإن تغيّرت التقسيمات التي ترسم فاصلا حادًّا بين “البلْديّة (بتسكين اللاّم والشدّ على الياء) من أصحاب الأملاك والمناصب في المدن وبين النّازحين من القرى من أجل التعليم والعمل. لقد اختلفت القاهرة عن تونس لأسباب تاريخية كثيرة، يمكن التوقف عند أهمها وهي أن تونس كانت حينها ترزح تحت الاستعمار الفرنسي وكان من الصعب أن يسمح آنذاك لأي فكر تنويري أن يرى النور، لهذا سُمِح لكل القوى المحاربة للفكر الاصلاحي أن تنشط بحرية وتضيّق عليه الخناق. أمّا في القاهرة فيمكننا أن نتكئ على ثلاثية نجيب محفوظ لقراءة الفترة نفسها، أي الفترة الممتدة بين ثورة 1919، و 1943…بالطبع ثمة تشابه صارخ بين حياة النّساء في المجتمعين، وتحكم الرجال في مفاصل الحياة عموما، لكن القاهرة كانت لا تكفُّ عن فتح سجالات ثقافية جعلت منها مدينة مضيئة وسط الشرق كله.
لنعد للحب والعلاقات الحميمة التي تؤجج القلوب والعقول المبدعة حتى لا يأخذنا الحديث عن أمزجة المدن وتاريخها بعيداً عن روح هذا الموضوع الحساس.
لقد شدّتني رواية أميرة غنيم وهي تسرد قصّة حب من نمط آخر، وهو الحب الذي يولد عن بعد وينتهي قبل أن يرى النور بشكل حقيقي، فالحدث كله مبني على واقعة “الحب المرفوض” وتلك الرسالة التي كُتِبت من طرف العاشق الولهان، لامرأة لا رأي لها ولا قرار، فهي المتلقّي الجاهل بالأمر، والمتهمة بدون تهمة رغم عظمتها، وما تلى ذلك من أحداث يكاد يجعلنا متأكدين أن واقع المرأة والرجل في الحب لم يتغير سوى تغيرات طفيفة منذ مائة عام، ثمة زيجات أدبية شبه ناجحة، ولكن بخلفية يسودها مناخ رمادي تشوبه علاقات سرية عديدة، أغلبها يمكن تصنيفه ضمن باب “التّحرّش”…!
إن السجون التي نعيش فيها منذ عصر الحدّاد وأقدم، مدعومة بمزيد من القضبان التي نشأت من إيديولوجيات ازدهرت في بلداننا في الأربعين سنة الأخيرة، وهنا يتبادر إلى ذهني سؤال على بساطته يبقى جد مهم، هل يمكن أن يحتفظ كاتب أو كاتبة عربيان برسائل حب تبادلاها في فترة من عمريهما حتى وإن كانا متزوجين؟
في زمن الورق كانت رسالة الحب إدانة مخيفة للمرأة، وللرجل أيضا، لهذا كُتبت تلك الرسائل المفعمة بالمشاعر الجميلة في حينها وانتهت أغلبها في سلال المهملات، قلّة منها أودعها أصحابها عند أصدقاء أمنين، لكن مع الزمن لم يبق منها أثر.
في الزمن الإلكتروني أصبح الحب تجربة آنية لا عمر لها، تُقرأ الرسالة وتمحى، ولهذا السلوك المهدّد بخوف دائم له نتائجه الوخيمة على نفس المبدع. يمنح الكاتب للعاطفة المركز الأول في عمله، ولوجوده أيضا، وأي خواء عاطفي يجعله يشعر بعدمية فائدته، بعضهم يشعر بنهاية حتمية لقلمه.
الدخول في تجارب حب غير مضمونة بحثاً عن الشغف غير مجدية لا في زمن مضى ولا في الزمن الإلكتروني، نستطيع أن نستنتج قلق الأدباء العاطفي من خلال نصوصهم، نصوص ينقصها الزخم الروحي الذي يجعلها تنبض بالحياة ونحن نقرأها. يُخفقُ الكاتب تماماً حين يجلس إلى أوراقه ويكتب نصًّا أدبياً كما لو أنّه في مهمّة إجبارية، قد يعبّر عن أفكاره بلغة سليمة وجميلة بحكم التجربة والخبرة، ولكن كل ما سيكتبه لن يختلف عن بيت فخم بدون مدفأة في ليلة شتوية.
ما يبدو متوفرا لدينا بكثرة هو الجوع للجسد وللعاطفة، تنكشف نصوصنا على كمية هائلة من هذا الجوع، كوننا نصف الجسد من حيث تنبثق الشهوة، وننكّل به ونلعنه ونبصق عليه، ثم نشتهيه مجدّدا، ونطعنه بكل ما أوتينا من شعور بالذنب والحقارة والنجاسة تجاهه. تتلوّى نصوصنا من الألم، وحين نجد الحب سرًّا نعيش آلامه أكثر من لذائذه.
لا شك أن رواية “نازلة دار الأكابر” تحتاج منا لوقفة طويلة وجادة، لتفكيك ثيمة الحب، لأنها رواية غنية بالرموز، والحقائق الموجعة. ولا شكّ أن ابتكار وضع رسالة الحب بين أرغفة الخبز له أكثر من معنى، فليس بالخبز وحده يحيا الإنسان.
كان الحب وسيظل بأهمية الخبز، ولكنّ ثورتنا لإعلان ذلك لم يحن أوانها بعد. إذ سواء في الغرب أو في الشرق كان الحب مرفوضاً، وكانت العلاقات المسموح بها هي الزيجات التي تُرضِي العائلات، وتخطط لها سلفا، بل إن الحب حتى في زمن الحريات في الغرب شابته ملابسات معقدة، لم يكن واضحا تماما بمقارنته مع الانسجام الجنسي مثلا، أو الرغبة في إبعاد شبح الوحدة.
ظلّ الحب بمفهومه الشّامل للشغف الروحي والفكري والجسدي بعيد المنال، ربما تحدثت عنه سيمون ديبوفوار، أو مارغريت دوراس، لكن لنعترف أن الكثير من اللاوعي والسذاجة قاد علاقاتنا نحو قبورها بدل إيصالها بسلام إلى أمكنة مضيئة تليق بها.
كثير من الهزّات العاطفية جعلتنا نرتجف أيضا، ولكنها فتوحات قصيرة الأمد لم تدم بهتجتها بما يكفي لكتابة نصوص خالدة تحدث التغيير المرجو في مجتمعنا المنهك. هي تلك الخطوة التي تنقصنا، خطوة شجاعة بحجم قفزة نيل أرميسترونغ على القمر، بعدها كل شيء لن يبقى على حاله.