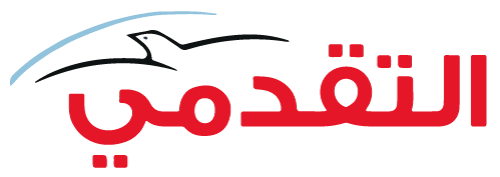في الجزء الثاني من رواية (أولاد الغيتو) “نجمة البحر”، ينتقل إلياس خوري إلى ما يحدث في حيفًا من حيث أنها مدينة تلعب دورًا رمزياً ومكانياً وكجزء من الحكاية الفلسطينية، لتصبح شاهداً على النكبة ومرآة على التغيرات التي طرأت بعد التهجير. فنجمة البحر ليست مجرد اسم في الرواية، بل كيان يتماهى مع البحر نفسه، فهي تجسد القدرة على البقاء والتجدد رغم الألم والمعاناة، وعلى هذا الأساس يُكمل ما بدأه في الجزء الأول “اسمي آدم” ويغوص بشكل أعمق في مأساة الفلسطينين مستعرضاً حياة الشخصيات التي تعيش في ظل النكبة والتهجير القسري من خلال بطل الرواية، آدم دنون، وهو الراوي والكاتب الذي يستخدم الحكي كوسيلة لفهم هويته وكشف الماضي بالسخرية وجماليّات اللغة وتعقيدات الواقع وتناقضاته التي برع في صوغها، وكفلسطيني تمزقه الحياة بين المنفي والاغتراب الداخلي، فيقول “حكاية الوادي تختلف عن حكاية اللدّ وتُشبهها في الآن نفسه. فعلى غرار اللدّ حيث سيّج الجيش الإسرائيليّ المنتصرُ حيّاً صغيراً يقع في مثلث الجامع – الكنيسة – المستشفى، قام الجيش بتسييج الوادي بالأسلاك الشائكة، بعدما أمر جميع مٓن تبقّى من سكّان حيفا بترك منازلهم والتجمُّع في وادي النسناس”.
حيفا، مدينة تم استباحتها بتفريغ سكانها من أهلها وبيوتها التي نُهبت وما عادوا يعرفون إلى أين يذهبون وإلى أي مكان يأوون فعاشوا في الذلّ، من غيتو مسيّج بالأسلاك الشائكة إلى حياة مسيّجة بالخوف وعدم الاطمئنان إلى المستقبل فوجدوا أنفسهم بلا روح وبلا أرض فضاعوا في دهاليز النكبة. “انهارت يافا وتشرّد ناسها ويركبوا القوارب التي أخذتهم إلى مجهول البحر والمنفى”، ومع ذلك لم تفارقهم رائحة حيفا وعبق رائحة الزيتون.
لم يترك الصهاينة للفلسطينيين أي شيء الاّ وسرقوه، “حتى المسبّات سرقوها، ما خلّولنا إشي”، “حتى الفلافل والحمّص صارا مطبخاً إسرائيلياً أصيلاً، ولم يعد ينقصنا سوى أن تسمُّوا الهولوكوست نكبة”. لكنّ حيفًا ستحفر في روحه وشمٓ اللقاء بين كرملها وبحرها، كأنّ المدينة خرجت من البحر أو تستعد للغطس فيه. وسيبقى أسير ذلك الشعور بأنّه يعيش على جناح حمامة بيضاء تستلقي وسط أمواج البحر الأبيض.
فقد الفلسطينين مدنهم مثلما فقدوا أرواحهم، فتشردوا وأصبحت تلك المدن والقرى والبلدات، بالنسبة لهم أشبه بالجِنان المفقودة بعد اضطرارهم إلى مغادرتها وبعد أن صادر اليهود بيوتهم. وبسبب الاحتلال الذي أفقد الناس حياتهم لم يعد باستطاعتهم رواية ما جرى، “وبدلاً من أن يرووا ماذا جرى يبتلعون الكلام كما يبتلعون دموعهم”. وكما وادي النسناس “تمّ احتلال البعنة ودير الأسد في سنة 1948، جمعوا أهل القريبتين في الساحة، ثم اختاروا أربعة رجال وساقوهم إلى الإعدام، إثنين من البعنة واثنين من دير الأسد. كما أن الكثير غادروا المدينة بحراً في أثناء الطرد الكبير الذي أعقب سقوط المدينة بأيدي قوات الهاغاناه”. ولم يكن بوسع من تبقي من مواطنيين التنقل من مدينة لأخرى الاّ بالتصريح من الحاكم العسكري، ومن في الغيتو لم يكن مسموحاً له بمغادرة الأسلاك الشائكة، اما من يخالف “سيكون مصيرهم كمصير الآخرين، أي العمل في المحاجر، وتعبيد طُرقات كوبونيات اليهود، والوقوف على أطلال أراضيهم المصادرة”. وبعد أن مات الإنسان ووُلد الوحش الصهيوني بالإستناد إلى أساطير وخرافات أرض الميعاد من خلال إضفاء القداسة على مشروع احتلال فلسطين، وتحويلها إلى وطن قوميّ لليهود، وطرد شعبها منها، نجحوا في بناء الجحيم للفلسطينيين، وبعد كلّ ذلك هل يحقّ للصهاينة الذين شرّدوا شعباً بأكمله أن يدّعوا أنّهم ورثة الضجايا؟
في الجزء الثاني من رواية (أولاد الغيتو) استطاع الياس خوري، بجدارة، وكما في الجزء الأول أن ينقل لنا صورة أدبية جميلة من معاناة الشعب الفلسطيني بربطه بين التجربة الفردية والجماعية وبطريقة أدبية فريدة، فقد حبك روايته من خلال سردية الناجين من مجزرة اللدّ عام 1948 ليتتبع الراوي حياتهم وبالتفصيل بعد أن هُجروا وهُمشوا ومن ثم كفاحهم من أجل العيش والتكيّف مع الواقع الجديد المفروض عليهم، فقد تابع الكاتب تلك الشخصيات عبر المذكرات والرسائل التي كتبها آدم دنون، مما أتاح للقراء الوقوف على الصراعات النفسية والسياسية التي يواجهها الفلسطينيون في ظل الاحتلال والنكبة.
وككل مأساة في التاريخ تظلّ الحالة الفلسطينية فريدة من نوعها عبرت عنها تلك الأصوات المتنوعة في الرواية من آدم دنون إلى حسقيل إلى ليلى وأم آدم وغيرها من الشخصيات، حيث مزج الكاتب بين تلك الشخصيات الواقعية والرمزية ومن ثم أخذ كلّ منها يروي جانباً من الحياة في الغيتو في سياق المأساة التي يعيشها ألشعب الفلسطيني جيل بعد جيل، كما اشتغل الياس خوري على معادلة الذاكرة والنسيان من خلال محاولة الاحتلال محو ذاكرة ألشعب الفلسطيني، ليعيد هذه الذاكرة عبر قوة الحكي كوسيلة لمقاومة النسيان والحفاظ على الذاكرة متوقدة لدحض السردية الصهيونية، ونجح في إبقاء الهوية الفلسطينية حاضرة سواء داخل فلسطين في ظل الاغتراب أو في الشتات حيث يعيشون في حالة من الانفصال بين الماضي والحاضر، ففتح آفاقًا جديدة لفهم التجربة الفلسطينية في جميع ابعادها.
استطاع الكاتب أيضاً أن يسلط الضوء على مأساة الفلسطيني بطريقة إنسانية وفلسفية من خلال قصص الشخصيات الفردية وجعل من هذه الشخصيات مأساة لشعب بأكمله ذاق الحرمان وفقدان الأمل. ظلّت حيفا مرتبطة بسؤال الهوية والذاكرة كمساحة لاستكشاف كيف يمكن للفرد أن يعيش في مكانٍ فقد هويته الأصلية كمدينة محتلة كانت رمزاً للاندماج الثقافي والجمال، والفلسطينيون الذين بقوا فيها يُعاملون كغرباء في مدينتهم بعد أن تحولت إلى فضاء للاغتراب والفقدان، ومن خلال حيفا استكمل الكاتب المأساة ليصل لباقي المدن الفلسطينية ابتداءاً من “الغيتو” في اللدّ، فارتبطت تلك المدن ببعضها في مصير مشترك، مما يجعل المدن الفلسطينية كأنها خريطة متشظية لوطن ضائع.
“نجمة البحر”، رغم كلّ شيء، رواية تبث الأمل في قدرة الفلسطينيين على الاستمرار والنهوض بعد كل خسارة رغم الصعاب العديدة، فهم يقاومون ويحاولون بكل ما استطاعوا من سبل رغم تكالب العالم ضدهم، فقد بيّن لنا الكاتب بأن الصراع مع العدو الصهيوني ليس مجرد صراع سياسي أو عسكري، بل هو مأساة إنسانية تتشابك فيها المصائر والهويات ليصبح في نهاية المطاف صراعاً وجودياً من قبيل التمسّك والإيمان بقضية التحرير، ولهذا استشهد الشاعرعبد الرحيم محمود، الشاعر الفلسطيني الذي مات مقاتلاً ضدّ الصهاينة في معركة الشجر في 13 حزيران 1948 وهو يقول: “سأحملُ روحيٓ على راحتي/ وألقي بها في مهاوي الرّدى/ فإما حياة تُسر الصديق/ وإمّا مماتّ يُغيظ العِدا/ ونٓفس الشهيد لها غايتان/ بلوغُ المنايا ونيل ُ المنى.”