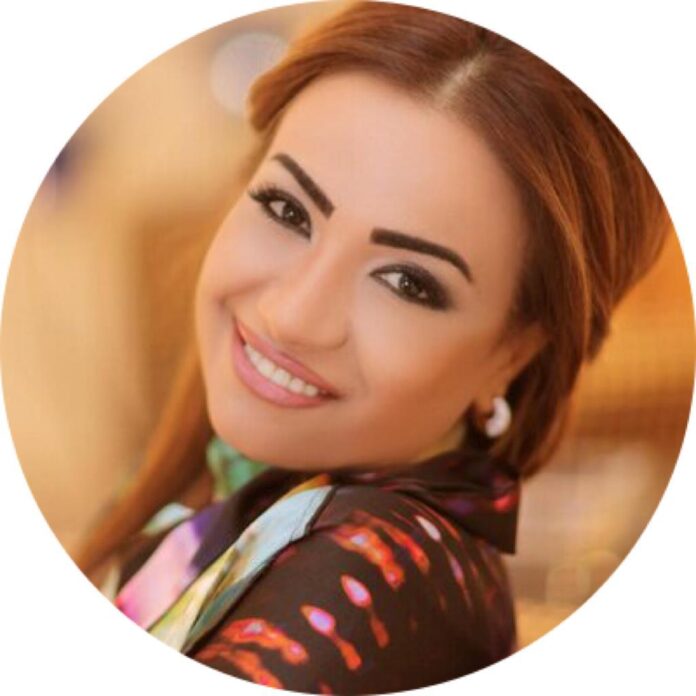لا يمكن اعتبار كتاب “الخوف من الخمسين” للأمريكية إريكا يونغ الصّادر عن دار المدى رواية، هي مذكّرات منتصف العمر فعلا كما أُشِير تحت العنوان مباشرة لتوضيح هذا الالتباس، ومع هذا فإنّ كلمة رواية تزيّن غلافها، كما أنّ أغلب القراءات التي قدّمت باللغة العربية بشأنه اعتبرته كذلك. أمّا النسخة الانجليزية فلا تحمل هذا التصنيف.
تروي إريكا يونغ تاريخ عائلتها لتفهم طبيعة علاقاتها بها، تسرد تفاصيل تعني القارئ الغربي بالدرجة الأولى، لكنّها أيضا تعنينا كقرّاء في العالم العربي، لأنّها تضيء على جوانب نجهلها حول الحياة الأمريكية بلسبياتها وإيجابياتها.
تعيدنا يونغ إلى فترة ما قبل تكوّنها في رحم والدتها، فتروي لنا رحلة عائلتين يهوديتين، كلٌّ منهما عاشت معاناتها الخاصة بسبب الحرب العالمية، عائلة والدها التي انحدرت من بولاندا وعائلة والدتها التي انحدرت من روسيا هاجرت إلى انجلترا ثم إلى أمريكا.
وصفت إريكا رحلة لقاء والديها كما لو أنّها في سهرة مع الأقارب، أشركت القارئ في فضاء حميمي على الطريقة الأمريكية في كتابة السيرة الذاتية والغيرية لكسبه كفرد من ذلك اللفيف العائلي.
بالطبع نجح الأمر، سواء في ثلاثيتها حول الخوف، وهي تروي مخاوف الإناث في مجتمع ذكوري، حارب النسويات دون أن يفهم جيدا معنى النسوية.
في مقطع جد مؤثّر وغير متوقع منا كقرّاء عربا تروي كيف وقف أمامها شاب عابث في عرس عائلي وقال لها: “أنتِ تؤلفين كتبا بذيئة، هلاّ تصرفتِ معي ببذاءة؟”. تقول: “غاص قلبي بين أضلعي، وتولّتني الكآبة وسط الاحتفالات”.
أن تشعر بالظُّلم في مجتمع يصنّف المرأة كائنا لا يصلح سوى للمتعة الجنسية وخدمات الزواج بدون مقابل، وأن تحاول تغيير تلك الصورة السيئة التي تلاحقك منذ ولادتك، ليس بالأمر السهل حتى في أمريكا التي تبدو لنا بلدا منحلا وكل المحرّمات مسموحة فيها.
يونغ تجعلنا نرى حقيقة اشتراكنا كنساء في المصير نفسه، وأيضا في ضرورة التضحية والمضي في الطريق نفسها لتحقيق بعض المكاسب وتصحيح نظرة المجتمع للنساء القائدات لمطالب المرأة بالمساواة مع الرجل في الحقوق الانسانية.
تقول : “إن الخوف من النّقد أسكنني مرّات عديدة في حياتي ككاتبة. وكان النّقد غالبا عنيفا، وشخصيا، وجارحا. لكنّ النّقد – كما تعلم الكاتبات جميعا من أفرا بن إلى جورج ساند إلى جورج إليوت إلى ميري مكارثي – هو أحد الأشياء الأولى التي على الكاتبة أن تتعلّم كيف تتعلّمها”.
ألا يذكّرنا هذا الكلام بما تتعرّض له الكاتبات العربيات خاصة اللواتي خضن في موضوعات حساسة مثل تعاطي المجتمع والمؤسسات القانونية مع منتهكي أجساد النساء، وتعنيفهن، وتصفيتهن بتسامح غريب، حتى أصبحت بعض الجرائم ضد المرأة مقبولة اجتماعيا مثل الجرائم التي أطلق عليها إسم “جرائم الشرف”.
قبول الجريمة ضد المرأة له بدايات ممتدة في الماضي، وله تفرّعات في الحاضر. فقتل المرأة يبدأ معنويا، مثل رفض عملها خارج البيت حتى عند الضرورة، وقد روت يونغ تجربتها مع زوجها والد ابنتها الوحيدة، حين وجدت نفسها المعيل الرئيسي للعائلة، ورغم أنّ ذلك بالنسبة لها كان نوعا من الخلاص، ومكافأة على اجتهادها، لكن زوجها قابله على أنّه انتقاص من رجولته، معتبرا نجاحها ثقلا أضيف لكاهله، وزاد من بشاعة صورته أمام نفسه كفاشل. وفيما كانت يونغ تحتفل بنجاحها المهني وانطلاق اسمها كالسهم في سماء مشاهير الكتّاب، لاح لها فشلها على الصعيد الشخصي، حين لم يعد هناك امكانية لتصحيح العلاقة مع والد طفلتها.
في الكتاب نقرأ عن واقع اليهود في حقبة الأربعينات. وعن الطبقية بين أثرياء اليهود وفقرائهم، وعن التمييز العنصري الذي قسّم الأمريكان وفق أصولهم التي قدموا منها. في أسواء حال فكرة اليهودي الفقير غير محبّذة أبدا في المجتمع آنذاك، ولعلها مستمرة إلى يومنا هذا، لكن بحدّة أقلّ.
تصدمنا الكاتبة بحقائق حول سر الإثنيات في بلد يجمع كل أنواع البشر من العالم، وهكذا فهي تنسف بكل معتقداتنا تجاه “أرض الأحلام” أمريكا.
يمكن لليهودي أن يتنصل من كل جذوره، وينكر كل الطقوس اليهودية، ويعلن إلحاده بشكل صريح، لكن ما إن ينفذ وقود شبابه وتفترسه أمراض الشيخوخة حتى يجد نفسه رهينة لعرقه وطائفته الدينية، يعود إليها مجبرا لأن لا أحد قد يهتم به كما يفعل ذويه، وحتى وإن تمكن بثروته على الحصول على رعاية بعيداً عنهم، فإن الموت يعيده ساكناً مستسلماً إلى مقابرهم.
تبدأ مخاوف يونغ من عمر الخمسين بعد احتكاكها بخالتها المصابة بالألزهايمر، وبعد إعادة نظر في محطّات عمرها المختلفة، وقد جرّبت جموح الشباب بكل ما أوتيت من قوة، تزوّجت أربع مرّات، وعاشت في بلدان عدة، وحقّقت نجاحات متتالية بكتبها ومحاضراتها، وأصبحت واحدة من أهم الكاتبات في أمريكا والعالم، ولكن علينا أن نعترف أن نجاحها يعود لاستثمارها الكامل في حياتها الشخصية، وكأن ما عاشته مجرّد تجارب من أجل الكتابة.
منذ كتابها “الخوف من الطيران” الصادر سنة 1973، والذي حقق نجاحا عظيما، بعد إثارته صخبا غير عادي بسبب جرأته في طرح أمور متعلقة بحياة المرأة الجنسية، والذي بيع منه أكثر من عشرين مليون نسخة، لم يعد بإمكان يونغ تخفيف سرعتها، ظلّت مندفعة نحو القمّة رغم تعثرها وحزنها وبكائها وانتكاسها من حين لآخر.
بدا النجاح والشهرة مثل قدر لا يمكن التّملُّص منه، مثل باقي تجاربها، خاصة مع الرّجال.
في مقطع مهم تتحدث عن تجربة عابرة، حيث تحوّل الجنس إلى ورطة وليس سبيلا للمتعة وللنسيان كما يبدو، فعند النضوج يصبح الاحساس بالآخر أهم من ممارسة الجنس نفسه. فتجربة لقاء امرأة عزباء برجل أعزب جذّاب لا تنتهي إلى الفراش ما دام عائق الاحساس ينتصب أمامهما مثل سور ضخم يصعب تسلّقه.
لاحظوا أن أغلب زيجاتنا تقوم على الاهتمام بتفاصيل لا حصر لها مغفلة هذا الاحساس. لهذا يمكن مواجهة أي قارئ يعتبر كتاب يونغ لا يخصنا، بالخواء الفظيع الذي يدمّر زيجاتنا في صمت، لأنها مبنية على معطيات اجتماعية لطالما تعاملت مع الرجال والنّساء وكأنهم ربوتات.
تكاد يونغ لا تغفل شيئا من حياة الأفراد في محيطها، بماضيهم وحاضرهم، وثقافاتهم، منبهة قُرّاءها أننا نولد ونترعرع في ثقافة ومع العمر ننتقل بين ثقافات مختلفة، فلا ثبات في حياة أي شخص مهما بدت له حياته مستقرّة ومضبوطة كالسّاعة، كما لا أحد بإمكانه النجاة من الأخطاء القاتلة، خاصة حين يتعلق الأمر بالثقة والحب.
عن خطورة العاطفة، نقرأ الكثير في هذا الكتاب الضخم (500 صفحة) أو لنقل (500 صفعة) تجعلنا نعيد قراءة ذواتنا بلا رحمة، ونقف أمام أخطائنا عراة تماما. ولو أن الكتاب أعيدت صياغته بشكل جيد، لاختُصِر منه الكثير من زائد الكلام الذي نتج عن ترجمة لن أقول أنها سيئة، ولكنها مُتعِبة، لأنها لم تعتمد ترجمة المعنى بقدر ما اهتمت بترجمة الكلمات، دون مراعاة للأسلوب. بعض الأفكار وصلتنا مشوّشة، وقد كان من الممكن التعبير عنها بطريقة أفضل. بالمختصر كتاب بهذا الحجم وبهذه الأهمية كان يجب أن يُعاد تحريره ليناسب القارئ العربي، وبالتّالي تقليص حجمه، وكلفة طباعته.
أحبُّ أن أشير أن لا ضغائن لديّ تجاه مترجم الكتاب أسامة منزلجي، فقد سبق وقرأت أعمالا كثيرة من ترجمته، ولكني أودُّ إثارة هذا الموضوع المتعلّق بالترجمات العربية التي لم تعد تهتم بصياغة اللغة التي يقدم بها الكتاب للقارئ، وكأنّ الهدف من الترجمة إنجازها كواجب لا تقديمها كنصّ له روح.