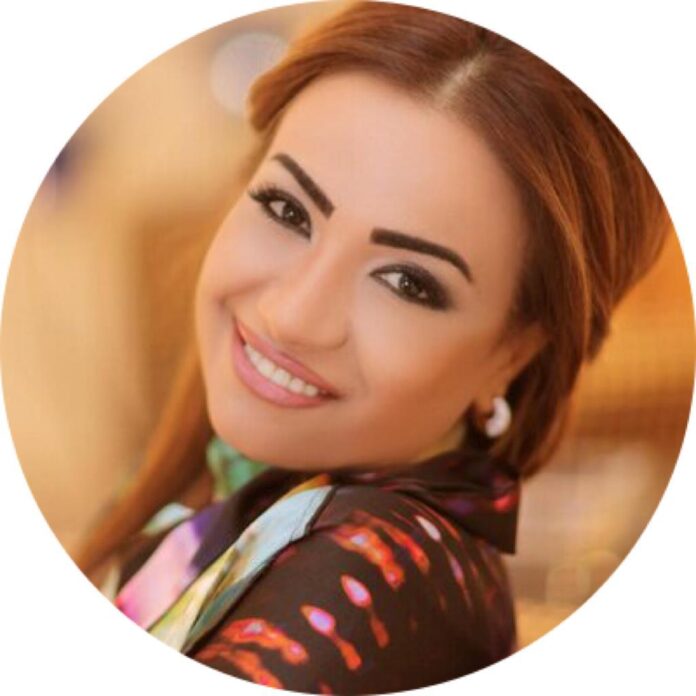على أيام الملك فؤاد أرادت الملكة نازلي أن تشتري عوّامة الفنانة منيرة المهدية، لكن هذه الأخيرة رفضت. هذه إحدى روايات السيدة إخلاص التي تعيش في عوّامة على النيل، ومثلها مثل غيرها جاءها قرار بإخلاء المكان. تتساءل أين ستذهب هي وقططها وطيورها وقد شاخت ولا مكان يأويها. وقبل أن يعتصرنا الألم لأن مصير السيدة العجوز مجهول، تطلُّ الكاتبة أهداف سويف وهي تروي المصير نفسه الذي ينتظرها، آخذة بنا إلى جولة صغيرة في عوّامتها، حيث خصصت فيها ركنا لها للكتابة، وأركانا للأحفاد وأخرى للأصدقاء الذين يهربون من ضجيج القاهرة، إلى عوّامة أهداف الهادئة في لقاءات لذيذة لا تخلو من الأدب والشعر والفن.
على ضفاف النيل كانت العوّامات موضة القرن الماضي، وقيل إنها وجدت منذ العهد العثماني، لكنها زادت وازدهرت في النصف الأول من القرن الماضي. سكنها أثرياء مصر، ونجومها، وقد ذكرت العوّمات كثيراً في الأدب المصري في القرن العشرين، أشهرها ربما عوّامة نجيب محفوظ، وهي العوّامة التي تزوّج فيها وأنجب فيها ابنتيه، وألهمته روايته “ثرثرة فوق النّيل” التي كادت تقضي على مستقبله الأدبي وتغيّبه في السجون.
صدرت أول طبعة من رواية “ثرثرة فوق النيل” العام 1966، وكانت صفعة للنظام الناصري الحالم بالتغيير والذي رسم صورة أفلاطونية لمصر الجديدة. محفوظ المراقب للوضع الاجتماعي والسياسي والثقافي من على عوّامته خرج بملاحظات قاسية سجّلها روائياً، ولأن الرواية أو الأدب مرآة عاكسة لواقع الشعوب، لم يكن الأمر ليمرَّ مرور الكرام.
عاش نجيب محفوظ في عوامته تلك ربع قرن، وكانت حتما مكانا ملهما له، ويمكنني أن أتخيّل محنة قامة أدبية مثل أهداف سويف وهي تقتلع من عوّامتها الجميلة، فهل أدرك المعنيون حجم الإساءة المعنوية لكاتبة بحجمها وانعكاس ذلك على سمعة القاهرة ودورها الثقافي الذي يزداد انحسارا؟
تاريخ هذه العوّامات لا يتوقف عند من سكنوا فيها مثل بديعة مصابني، ونجيب الريحاني، ومنيرة المهدية، ومحمد عبد المطّلب، وتحية كاريوكا، وسامية جمال، والشاعر حافظ إبراهيم الذي سُمي بشاعر النيل لأنّه ولد في إحداها.
إن العوّامة مكان ذو أبعاد جمالية، هذا غير ما تمثّله لأصحابها، فهي المكان الآمن لهم للحياة والاستمرارية. وكان بالإمكان التعامل معها كإرث ثقافي، كما هو معمول به في بعض الدول التي تستثمر في بيوت الأدباء والفنانين كمتاحف تحقق مداخيل سنوية هائلة لخزائن الدولة.
سنة 1846 نشرت جورج صاند روايتها الشهيرة “بركة الشيطان” والغريب أنها تصف المكان على أنه بركة من بين آلاف البرك تحيط به تربة فقيرة مغطّاة بأوراق ميتة تنبعث منه رائحة حمضية غير جذّابة ومع ذلك فهي الوجهة الأكثر طلبا للسياح. ستة وثلاثون ألف زائر سنوي يقصد هذا المكان لرؤية بحيرة جورج صاند ومن ثم قصد بيتها الذي يبعد حوالي ثماني كيلومترات عن المكان. ينجذب هؤلاء إلى البركة وإلى الجدران التي شهدت ذكريات جميلة للقاءات صاند مع مشاهير زمنها مثل شوبان وديلاكروا وفلوبير.
صاند التي تنحدر من قرية نوهانت في إقليم أندر بفرنسا أُعتُبِرت رمزا من رموز المنطقة الثقافية، لهذا اشترت الدولة المنزل العام 1952 وحافظت عليه وحوّلته لمتحف.
هذه الظّاهرة الجميلة والقوية للتعبئة السياحية تمارسها دول تعرف قيمة الثقافة، ولعلّ المملكة المتحدّة كانت السبّاقة لتكريس بعض القرى التي عاش فيها كتّاب وشعراء، مثل قرية هاوورث التي عاشت فيها الأخوات برونتي (شارلوت وإيميلي وآن) غرب مقاطعة يوركشاير التي تجذب مئات الآلاف من السيّاح من جميع أنحاء العالم كل عام. بل إن الأزمة المادية التي تعرّض لها البيت بسبب جائحة كورونا سرعان ما تمّ حلُّها حين هبت عائلة الشاعر ت. س. إليوت لإنقاذه بتقديم هبة مالية معتبرة ليظلّ مفتوحا للجمهور، ويذكر أن سبعين ألف زائر سنويا يترددون على البيت من كل العالم.
متحف برونتي (بيت القسيس) كما يطلق عليه، تمّ إدراجه في المرتبة الأولى في قائمة التراث الوطني الإنجليزي. وعمره اليوم 244 سنة. وقد كان بيتا للعائلة برونتي المكوّنة من الأب والأم وستة أطفال، والغريب أن المستنقعات القريبة من المكان كان لها تأثير عميق على كتابات الأخوات برونتي، وهي الأخرى تستهوي زوار المتحف.
في العالم العربي نادرة جدًّا هذه المبادرات التي تحافظ على الذّاكرة الثقافية للأمكنة، وإن كانت بعض الاستثناءات مرتبطة ارتباطا وثيقا بثقافة المسؤول ومستوى وعيه، فإنّ الكوارث التي حلّت بذاكرتنا الثقافية كان سببها دائما الإدارة الفاشلة لمسؤولين تكوّنوا كإداريين لا يختلفون عن موظفي القطاعات العامة الذين يفتقرون لثقافة حقيقية ورؤية جمالية للفضاء العام.
لقد قرأت الكثير مما كُتِب عن عوّامات النيل، وتأثرت بما قالته أهداف سويف، ولا أدري إن خطر ببالها أن تطلب دعم الكتّاب البريطانيين والعالميين الذين تعرفهم بحكم علاقاتها خلال مشوارها العلمي والأدبي ذي الأهمية العالية، لإبقاء عوّامتها قائمة مع عوّامات أخرى. لقد أردت أن أشارك أفكاري بصوت عالٍ عسى أن نحفظ ذاكرتنا من التّلف، فتتحوّل عوّامة سويف إلى إقامة إبداعية دائمة لكتّاب العالم.
لنعتبر هذا الكلام نداء لدعم سويف والتّاريخ الذهبي لرموز الأدب المصري الذين صنعوا بصمته العالمية تماما مثل الأهرامات العظيمة وحضارة مصر الفرعونية التي قاومت كل العواصف التي هبت على ذاكرتها ولم تستطع اقتلاعها من جذورها.
صحيح أن العوّامة ليست بحجم الأهرامات، لكنها جزء كبير ومهم من الذاكرة الثقافية التي نعتز بها جميعا لأنها غذّت أذواقنا الجمالية وألهمت محفوظ العربي الوحيد الذي نال جائزة نوبل للآداب، وألهمت كثيرين لا نعرفهم جعلوا حياتنا أبهى بألحانهم، وأشعارهم، وأفلامهم، ومنحوا للقاهرة إسم “أم الدنيا” بجدارة.
لا أحد يزور مصر إلا وتكون له زيارة على الأقل لإحدى العوّامات مع أصدقاء مصريين يعتبرونها أماكن للسّمر واللقاءات الثقافية المميزة، وهي تختلف تماما عن لقاءات المؤتمرات والملتقيات المنظّمة في الفنادق والمطاعم الفخمة. وفي اعتقادي ما يبحث عنه السّائح القادم من أوروبا أو العالم العربي أو من أمريكا ليس رؤية الأهرامات فقط، وتناول الطعام في مطاعم مطلّة على النّيل، فما يملكه هذا السائح في بلده ربما أجمل بكثير مما نخطط لبنائه، لكنه لا يملك نجيب محفوظ، ولا حافظ إبراهيم، ولا عبد الحليم حافظ، حفظ الله ذكراهم جميعاً وكل صنع مجد مصر الفني والأدبي.
لقد كان المكان ولا يزال حاملاً لروح وبصمة ساكنيه، وهذا ما يميزه عن غيره من الأماكن. وإن كان الأدباء العرب لم يسجلوا أي موقف إيجابي تجاه الصرخة النّاعمة التي أطلقتها الأديبة العالمية أهداف سويف، بسبب انهزامية غُرِست فيهم بعد تهميشهم المستمر منذ عقود من الزّمن فإن الأمر مختلف بالنسبة لسويف، لأنها تختلف بمكاسبها الكبيرة التي حقّقتها من اللغة الإنجليزية التي تكتب بها ووزنها على المستوى العالمي ككاتبة.
إنّها خطوة قد تنقذ عوّامة سويف وعوّامات أخرى إن تحوّلت لإقامات إبداعية يحلم بها كُتّاب كثر في بلاد كيلوباترا ونفرتيتي، والشمس المشرقة على مدار السنة، والنيل بكل رونقه. فإن كانت مستنقعات نهر برين وشانتلوب في فرنسا تجذب مئات الآلاف من السياح بسبب روايات جورج صاند، فكيف بالنيل الساحر وعوّاماته وقد خلّدها نجيب محفوظ في أدبه، كاتبا فيها وعنها، إضافة إلى ما كتبه غيره، وما نتج من فن انبثق منها كفضاء مُلهم لا يتوقف عن سحر الأدباء وأهل الفن.